 (لغة الأرض) وأسئلة الخراب والقبح
(لغة الأرض) وأسئلة الخراب والقبح
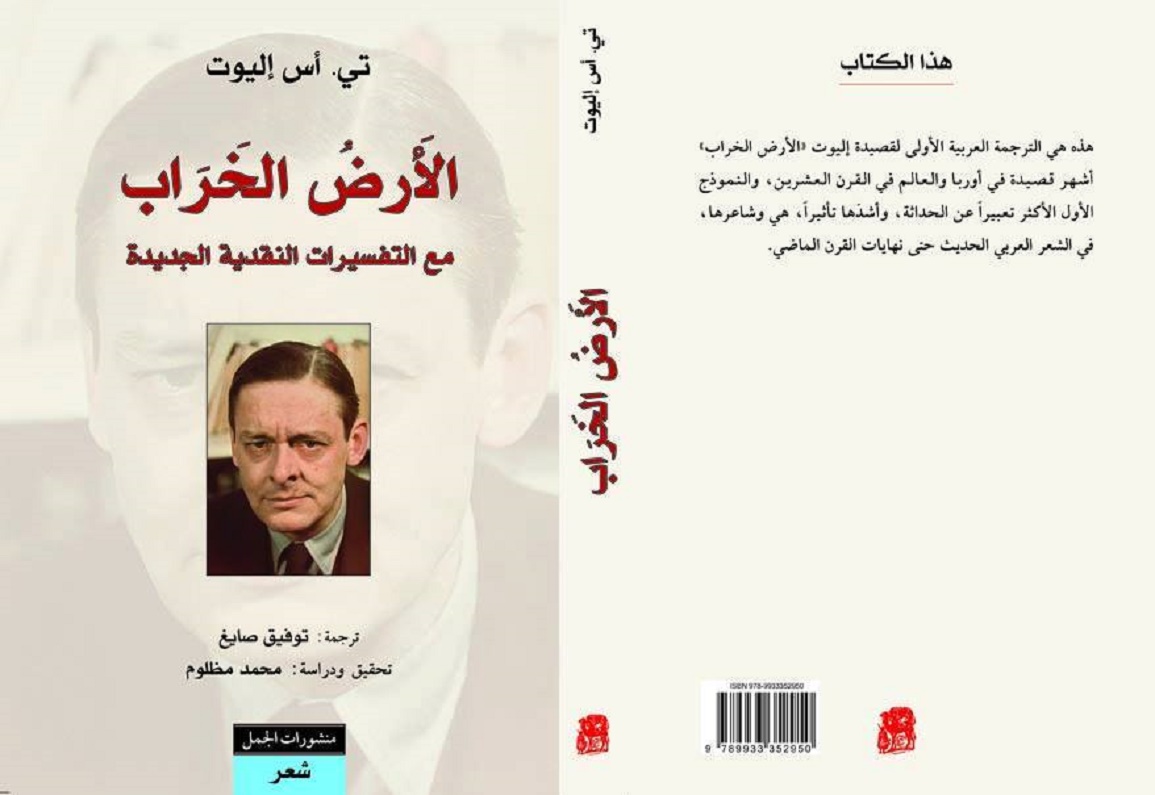 |
| (لغة الأرض) وأسئلة الخراب والقبح |
  
|
 فنارات فنارات |
 أضيف بواسـطة addustor أضيف بواسـطة addustor |
 الكاتب الكاتب |
| النـص :
د. سمير الخليل تمثّل نصوص المجموعة القصصّية (لغة الأرض) للقاص (علي حسين عبيد) أنموذجاً من القصص التي تتمثّل الواقع تمثلاً حقيقياً، وتشتبك معه اشتباكاً يعبّر عن ميل واقعي، انطلاقاً من صدق التوجه والاقتراب من الوقائع والحقائق بشكل يضمر نوعاً من التوّجه الحقيقي والإنساني لرسم معالم وعوالم الخراب والقبح والعتمة التي تجتاح الواقع الإنساني بكلّ أبعاده الاجتماعية والوجودية والسايكولوجية، وضياع الذات الإنسانية المقهورة والمقموعة تحت سطوة الحروب والضياع والتشظّي، وكأن الخراب الفادح هو لغة الأرض البور التي اجتاحها طوفان بدائي، وتلك هي الإشارة المرتبطة بسيمياء العنوان وتعبيره عمّا يحدث بالأرض من صراع وتشتت، والمحنة التي أصابت شخصيّات القصص جراء الأحداث والأقدار والوقائع الكالحة من حروب وموت وغياب وقلق عدمي جرّاء ذلك، وكأننا في واقع (أرضي) يفتقد إلى القيم والمرجعيات التي تنقذ الإنسان والأوطان من الإحباطات والمحن وظواهر النكوص القيمي. ولعلّ أهم خصائص الكتابة في هذه المجموعة أن قصصها تنتمي إلى النسق الواقعي أو أنها تبدو أكثر واقعية من الواقع بحسب توصيف (بلينسكي) الناقد الروسي حول قصّة (الشقاء) لتشيخوف، فالقاص يمتلك القدرة على التقاط مضامين وأحداث ترتبط بالواقع المأساوي الذي يعيشه الإنسان بسبب الحروب والقمع السياسي والتهميش والإغتراب والعوز وأزمات الواقع المتناسلة. ويلفتنا من الظواهر الفنيّة في هذه المجموعة ميل القاص لوضع شخصياته في لحظة تأزّم أو هم أكبر في قدراتهم، لكنّ المجموعة وشخصياتها تبدو أكثر تماسكاً وحبّاً للحياة والقدرة على المقاومة، ويبرع القاص في وضع استهلالات وصفيّة ومشهديّة للدخول في عوالم القص والاختزال ورسم ملامح الشخصيّات بدقة التفاصيل، ويميل القاص إلى رصد الشخصيّة وهي محاصرة بالحرب أو العوز أو أنها تعاني انكسار حلمها، وقلق وجودها، ومن خلال هذا الميل نجد القصص تنطوي على بعد سايكولوجي في الكشف عن أعماق وهواجس الشخصيّات، ولذلك نلحظ بعض القصص تقوم في بنيتها السرديّة على تقنية السرد الذاتي، والإفضاء عن طريق ضمير المتكلّم لأنه الأقدر على تجسيد المعاناة والمكابدة الشعورية والداخلية، والصور والمضامين التي تجسّدها هذه الإضمامة من القصص تنطوي على ادانة الواقع وتعرية الحروب والأزمات التي تثقل كاهل الأبطال أو الشخصيّات الرئيسية. سلّط الكاتب الضوء على مقاطع أو اشارات دالّة على ظاهرة النزوح والغربة المكانية التي تمثّل احدى دلالات التأزم السياسي والاجتماعي، وتصبح معاناة الإنسان فادحة وهو يعاني من الأمكنة المعادية أو غير الأليفة التي وجد نفسه مضطراً في خضم الاغتراب والهموم الضاغطة، ولكن واقعية النصوص لا تتأطّر بالإفراط والتعمّق الإنساني فحسب بل نجد أنها تخلق انزياحاً وتحوّلاً في دلالتها باتّجاه الترميز والإحالة، فهي نصوص واقعية تمتلك انفتاحاً على الرمز والإيحاء ولا تكتفي بالتجسيد الواقعي المجرّد، وذلك ما يجعلها اكثر عمقاً ومتعة وتأثيراً. ففي قصّة (أنين متوارث) نلحظ أن القصّة تعالج لحظة مأزومة وموقفاً يمثّل أزمة حقيقية ويجسّد القلق الإنساني في مكان صحراوي، إذ تروي القصّة حدوث المخاض لشقيقة الراوي الشخصيّة الذي يروي الأحداث بالسرد الذاتي ويأتي هذا المخاض الخطير في مكان صحراوي لا توجد فيه أي مستشفيات أو امكانيات لإنقاذ المرأة من حراجة وفداحة الموقف، وينقلنا القاص إلى عوالم البحث والتقصّي للعثور على امرأة – أم سعد – لتنقذ الموقف في اللحظات الأخيرة، وسط يأس وإحباط، والقصة تمتلك اشتراطات البناء الفنيّ والقدرة على خلق التحوّلات، ووضع النهاية الدالّة ونلحظ الإشارة الدالّة على معاناة النزوح الذي تسبب في حدوث لحظة التأزم ومحنة المخاض: "في صحراء قصّية سوف يكون مكاناً لمخاض أقرب الناس إلى نفسي، إنها شقيقة الروح والقلب والجسد، قفزت من مكاني كالملسوع وصرخت على الجميع أن ينهضوا من النوم نهضوا جميعاً، خرجوا من فتحة البيت النايلون الواطئ، ودخلوا في حالة انذار قصوى، والظلام يسود مثلما تسود الحرب على كل شيء، رأيت إحدى النازحات تقترب من شقيقتي ثمّ هرعت إليّ وقالت:
وتكمن جمالية هذه القصّة في الاختزال والدخول إلى لبّ الموضوعة، وخلق المشاهد التي تجسّد أزمة الإنسان في خضم النزوح والمكابدة وفي مكان صحراوي قصيّ، وتتجلّى لحظات يصف بها البطل ذروة الأزمة وضياع الأمل الذي يشير إلى أن النزوح يشكّل دلالة على الضياع والتشتّت بالبقاء: "في لحظات القنوط التي نعيشها الآن، هذه اللحظات التي هيمن فيها البؤس والقلق والخوف والموت على العالم بأسره، في هذه اللحظات المنحوتة من اليأس المطلق، قد تمنحنا الأقدار فرصة أخيرة إلى المعجزة أو هي المعجزة بعينها، والأغرب في هذا أننا لم نكن في انتظارها". (المجموعة: 12)، وتنتهي القصّة بولادة الطفل، وانتهاء المأزق، وترد إشارة في هذه النهاية إلى أن زوج الشقيقة وهي تكابد المخاض، كان في عالم الغياب بعد أن اختطفته الحرب، وبذلك تحمل القصّة كثيراً من الدلالات والإستلهام الواقعي لما تفرزه الحروب والنزوحات من مآس مقيتة. ترصد قصّة (أزيز الذباب) حالة الفوضى والنهب والحرق التي رافقت سقوط النظام وبروز ظواهر متناقضة، وهي الأقرب إلى المشهد السيريالي حين هجم كثير من الناس على المخازن والوزارات والمؤسسات وأماكن خزن الأغذية للاستيلاء عليها، ويتعمق القاص في اظهار هذه المشاهد ويلتقط تناقض المواقف والآراء، والتوجّهات التي يدافع عنها البعض ويبرّرها، في حين نجد من يمتنع عن ممارسة هذه الطقوس، والقصة من النوع الذي يقوم بناؤه على الوصف والرصد، والبنية الأفقية، وهي قصّة تنطوي على عرض الشخصيّات والمواقف أي أنّها قصّة مشهديّة وجماليّة سردها أنه جاء على شكل تداعيات في ذهن الشخصيّة الرئيسية وبصيغة ضمير المتكلم أي الراوي المتماثل حكائياً، فهو يروي ويشارك في الأحداث أو نقل الصور والوقائع: "خمّنت إنَّ ما يحدث لن يمر من دون تداعيات ونحن نسير في الاتجاه الخاطيء، بعضهم يقول علينا، الفقراء يقتصون الآن من الأغنياء، وهذا القصاص مؤيد بنص قرآني، (ولكم في القصاص حياة...) وهكذا يفلسفون الأمور كي تأتي في صالحهم، ويقف معهم بعض الذين ركبوا الموجة، ومنهم رجال دين غير معروفين، يدعمون الثأر والفتن بالخفاء، وفي العلن يرفضون ذلك نفاقاً في وضح النهار". (المجموعة: 36)، وقد أدرك القاص أن القصّة لا تقوم على بنية درامية وصراع جلي، بل هي تجسّد تناقض الآراء واختلاف وجهات النظر في الظواهر التي رافقت التحول الدراماتيكي، وسقوط الاستبداد، بهذه السرعة غير المتوقعة، وهي لحظة تاريخية فارقة اختلف الناس في النظر إلى نتائجها، وبذلك فإن القصّة امتلكت البعد التوثيقي، وتسجيل هذه اللحظة وتصوير مشهديّة تدل على هذا التناقض والجدل حول ما يحدث، وتطرح أسئلة كثيرة حول شرعية ومبررات التجاوز على الممتلكات العامة أو عدم شرعيتها. وتمثّل قصّة (النافذة) حالة القلق والخوف والإشتياق والانتظار الذي يصيب الزوجة حين تنتظر وتتطلّع من النافذة لرؤية أو سماع صوت زوجها الذي غادرها إلى الحرب، وتتخذ من النافذة المكان الوحيد الذي يوصلها بالعالم الخارجي وعالم زوجها المنتظر: "ارتقيتُ سُلَّم البيت درجة.. درجة.. إلى الطابق العلوي من البيت، كان جسدي منهكاً بالحزن وألم الفقدان، ودخلت غرفتي، وجلست على مقعد من الخشب المغلف بالإسفنج، وقماش وردي من القطيفة، كان المقعد محاذياً للشباك المطلّ على الشارع الرئيس في الحي، كان هذا هو مكاني الثابت والمحبّب إلى قلبي، وكان طفلي يلعب مع جدّته ويلاطفها بصوته الرقيق...". (المجموعة: 53)، ويجسد النص الانتظار اليومي والجلوس الطويل أمام النافذة التي من خلالها يمكن للزوجة أن ترى الزوج العائد من بعيد وهي مشغولة عن كل العالم الذي حولها وتتحوّل النافذة إلى دالّة رمزية للأمل، والتطلّع إلى حلم مجيء الزوج أو الجندي الغائب. لعلّ جمالية السرد تكمن في أنه جاء على لسان الزوجة وبصيغة ضمير المتكلم، إذ تصف هواجسها وقلقها وتستحضر ذكرياتها وتنظر إلى ملابس وحاجيات الزوج الغائب، إنه استحضار سايكولوجي ينم عن فكرة أن الحرب تستهدف الأمهات والزوجات المنتظرات دوماً للأمل، أمام الطرق والنوافذ، والقصة في مستواها الواقعي والرمزي ترتكز على إدانة الحرب وبشاعتها، لأنّها تجلب الألم والقسوة والانتظارات المرّة، وتنتهي القصّة بزخمها السايكولوجي بسماع طرقات مميّزة على الباب، ونلحظ أن هناك تقنيّة تقطيع القصّة وتحويلها إلى مقاطع معنونة بالترقيم كوسيلة يلجأ إليها الكاتب لجعل القصّة تبتعد عن البناء التراتبي، والسرد الخطي فالقاص يعتمد رصد المشاهد بانتقاء اللّحظات والمساحات المتوترّة والدالّة. وتعبّر قصّة (حب جامعي) عن حالة انسانية غالباً ما تحدث في ايام الدراسة الجامعية حيث يرتبط الشخصيّة طالب الكلّية، بزميلته (سميرة) التي جمع بينهما حبّ الدراسة والتفوق، وتتطور العلاقة إلى الحد الذي تأخذه معها وتعرّفه على أمها وأخيها وظلّ ينظر في أجواء ولوحات البيت الأنيق: "هذا العالم الساحر أريد أن أعيش فيه إلى الأبد اطلّت امرأة في الستين، وجهها أحمر مثل رمانة رائجة، لها عينان تشعان بقوّة، بدت ابتسامتها فريدة من نوعها، رحبّت بي بجمال وصدق، وشكرتني بعد أن قدمتني لها ابنتها سميرة، بعد لحظات جاء مراهق جميل قالت سميرة هذا أخي إبراهيم". (المجموعة: 118). ويعيش الشخصيّة المحورية حالة من التعالق والهيام والتوق إلى الحلم الذي سيجمعه مع (سميرة) وتمضي سنوات الدراسة وفي السنة الأخيرة تبدأ (سميرة) بسلوك مغاير إذ تبتعد عنه ولم يشعر بالألفة والتوق الذي عهده منها، وتنتهي القصّة بهذا المشهد المؤثر: "لقد رأيت الرجل الذي سرق منّي حبيبتي في آخر يوم للسنة الأخيرة، وهو يصطحبها بسيارة فارهة، وتبدو عليه علامات الغنى والترف، وحين مرّت السيارة بجانبي لم تلتفت سميرة إليّ، لكنني تأكدّت تماماً إنها فقدت عذوبتها وتلقائيتها وإنسانيتها إلى الأبد...". (المجموعة: 120)، والقصة بعفويتها وجمالية تجسّد الفكرة توافرت على سرد فيه المتعة والبناء وصولاً إلى لحظة الاحباط والإنكسار، ومثلّت النهاية ضربة غير متوقعّة مما خلق التأثير في المتلقي وادانة مثل هذا السلوك الذي يعبّر عن هيمنة الطمع والفوز بالإغراءات الطبقية على حساب العاطفة والعلاقات الإنسانية. ويقدّم القاص رؤية بهذه الإشكالية والتناقض في وجهات النظر وتناقض السلوك المزدوج، وتتماثل هذه القصّة مع كثير من قصص المجموعة بأنّها تتناول القيم واختلاف الناس في النظر اليها، وذلك أحدث انزياحاً دلالياً عبر الانتقال من البناء الجمالي إلى المدلول الفكري والقيمي، وفي معظم القصص نلحظ هذه اللحظة الفارقة التي تنطوي على التناقض في السلوك أو الاعتقاد والاهتمام بالقيم التي تكشف عن جوهر ونزوع الشخصيّات المتناقضة. أمّا قصّة (لغة الأرض) التي تحمل المجموعة القصصية عنوانها فإنها قصّة مؤثرة تمزج بين النسق الواقعي والنسق الرمزي، وتتخذ من المفارقة وسيلة للإشارة إلى أفكار ومضامين انسانية إذ ترتكز على التبشير بقيم العمل النافع والخير والكفاح، وتؤمي إلى نبذ الحروب وقبحها، فـ(سلام) الشخصيّة الرئيسية يرث عن أبيه البيت والحديقة الكبيرة، ويستدعي الفلاح القديم (خنياب) لمساعدته في مكافحة أمراض النباتات وحرث الأرض، وخلال عملية الحرث وتنقية المزروعات يعثر الفلاح على شيئين مهمين ومتناقضين: فقد عثر على مخطوط وبعد أن اطلع (سلام) عليه أدرك أنه دفن بالأرض حتى يجده من يعمل ويزرع، ويكتشف بأنه يتضمن وصايا للعمل المثمر والخير والكفاح والإخلاص والابتعاد عن كل الشرور، فهذه هي وصية الراحلين، وأمّا الشيء الآخر الذي عثر عليه (خنياب) فهو بندقية قد لفّت بالنايلون وحفظت داخل الأرض وبعد أن يتأمّل (سلام) بهذه المفاجآت أو المخزونات يدرك حقيقة الرسالة التي قدّمها أبوه، والراحلون بأن العمل والخير هو الذي يجب أن يهتم به الإنسان، ويخلص إليه، وفي الوقت نفسه ترمز البندقية إلى تجنب الحروب والعنف والشرور، والدفاع بها عن الشرف والأرض ويتحول النسق من حادثة أو مفارقة غير متوقعة إلى انزياح رمزي، إذ نلحظ القاص يميل إلى هذه الثنائية المتضادة في أغلب القص كما أشرنا وهذه القصّة المعبرة هي أنموذج على هذا الاشتغال، "الوصية التي وضعها الراحلون في الورقة الأخيرة، أنّهم حمّلوا فيها أول شخص يعثر على هذه الأوراق أمانة الإحتفاظ بها، والعمل على توصيلها للناس قدر الإمكان لكي يطلّعوا عليها، ثم ختموا وصيّتهم بجملة جاءت بصيغة الأمر: "تجنّبوا الحروب التي عانى منها الرحلون". (المجموعة: 128). ولعل هذه القصّة تمثل الأنموذج الذي ترتكز عليه تجربة القاص (علي حسين عبيد في هذا النمط من الكتابة الواقعية والاشتباك مع ظواهر ووقائع ومفارقات ومواقف انسانية تحمل في جوهرها صراعاً قيمياً باتجاه الثنائيات المتضادّة، ويجسّد وجود طرفين أو متجّهين يختلفان في النظر إلى الأحداث من وجهة نظر أحادية تتقاطع مع رؤية ووجهة نظر الآخر، وبذلك فإنه يقدم مساحة أو فضاء لصراع الذات مع الآخر. وعبر جمالية الاشتغال والعمق الإنساني في الدلالة، تجسّد القصص نوعاً من الانزياح باتجاه الإشتغال والتأطير الرمزي ويمكن تسمية هذا النمط من الكتابة بالواقعية الاجتماعية والإنسانية ذات المحمول والإحالة الرمزية، ونجد في قصّة (لغة الأرض) توظيفاً للمخطوط ودلالاته وإشارته (الميتاسردية) وظاهرة أو دلالة المخطوط غالباً ما يعالجها الفن الروائي لكن القاص ينفرد بتوظيفها في القصّة القصيرة، وتعكس المجموعة إجمالاً تجربة قصصية تنطوي على دلالات واشتغالات متقدمة شكلاً ومضموناً. |
| المشـاهدات 33 تاريخ الإضافـة 26/04/2025 رقم المحتوى 62146 |
 أخبار مشـابهة
أخبار مشـابهة |
 الديوانية تنهض من تحت الخراب الديوانية تنهض من تحت الخراب |
 |
 المهرجان يستعيد سيرة كوكب الشرق أم كلثوم
مهرجان أفينيون المسرحي يحتفي باللغة العربية ((لغة النور والمعرفة)) المهرجان يستعيد سيرة كوكب الشرق أم كلثوم
مهرجان أفينيون المسرحي يحتفي باللغة العربية ((لغة النور والمعرفة)) |
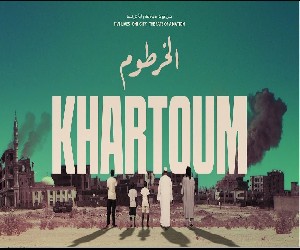 |
 أرملة وموظف حكومي وبائع شاي ومقاتل وطفلان يحيون الأمل رغم الخراب
الخرطوم.. فيلم وثائق تجريبي يعالج مأساة الحرب في السودان أرملة وموظف حكومي وبائع شاي ومقاتل وطفلان يحيون الأمل رغم الخراب
الخرطوم.. فيلم وثائق تجريبي يعالج مأساة الحرب في السودان |
 |
 حين تتعثر الاساطير
إينانا ..سردية الحلم والخراب!! حين تتعثر الاساطير
إينانا ..سردية الحلم والخراب!! |
 |
 سوريا… وطن تائه في زحام الخراب سوريا… وطن تائه في زحام الخراب |
 توقيـت بغداد
توقيـت بغداد 


