 د. منى قابل ذات قصيدة
د. منى قابل ذات قصيدة
 |
| د. منى قابل ذات قصيدة |
  
|
 فنارات فنارات |
 أضيف بواسـطة addustor أضيف بواسـطة addustor |
 الكاتب الكاتب |
| النـص :
ناصر أبو عون د. منى قابل في هذا النصّ تُطبطب بكفِّ البراءة على ظهر الحنين، وتُربِّت على كتف اللهفة، وتقضم أظافر الشوق، وتحضن وجع الفِراق، وتتكوّر على ألم الفجيعة في ركن قصيٍّ من القصيدة.. في هذا النصّ تتهادى الكلمات على جناح نسمة باردة تترجّل على كورنيش الإسكندرية، وتقبّل خُدود العشاقّ على حين دهشة، وتُشبِّك أصابع المارّين على وعد باللقاء، تحت رذاذ موجة اشتاقت لدفء شفاه استكانت لرعشةٍ عابرة. [لكن ما تبقّى بعد الفراق/لم يكُن عنك فقط،/ كان عنّي،/ عن كائنٍ خرج من ذاته/ ولم يعرف الطريقَ للعودة./ أشدّ الأشياء ألمًا، يا حبيبي،/ أن يُثمر في يدِ غيري/ ما زرعتُهُ بيدي،/ أن أراكَ تُزهر،/ ولم أكن التُربة التي اخترتها للبقاء،/ مع أن كلّ بذورك/ علِقت بطرفِ فستاني]. إنّ الدخول إلى نص د. منى قابل لا يتأتى إلا من خلفية نظرية ننطلق منها في فهم محاور الإبداع الشعري، والسباحة في بحر قصيدتها يحتاج إلى ركوب قارب الانزياح (L’écart)للتجديف نحو شاطيء المعرفة لإدراك تصورات البنيوية الشعرية المتعلقة بالأوجه البلاغية في خارطة إبداعها المتنوّعة ما بين ممارسة العلاج النفسي كطبيبة متمرسة، والرواية كساردة، والقصيدة كشاعرة، ناهيك عن رسومها الوحشية. وعلى كلٍّ فإن ارتأينا (الانزياح) يمارس حضورا طاغيا في سائر منتوجها الإبداعي؛ حيث نعثر عليه في الفكرة المركزية للنصّ وبشكل صريح وبُؤريّ كما نظَّر له (جون كوهن)، ونضبطه متلبسًّا بالإضمار وراء المفاهيم الموازية للقيام بوظيفة شعرية خالصة وفق رؤية (ياكبسون)، أو يعزف لنا على أوتار (الشفافية) كما نظّر له (تودروف)؛ ولاشك إن الاتكاء على مفهوم الانزياح في قراءة نصوص د. منى قابل باعث على البحث عن "خصائص مميزة" للغة شعرية عالية على نحو ما نقرأ في هذا المقطع:[أنا الرواية التي لم تُكتب حتى النهاية/ لأن المؤلف خاف من الصدق،/ أو لأن الحبّ/ لم يكن صالحًا للطبع./ أنا الشجارُ الذي توقّف عند حدودِ الكبرياء،/ كأننا خشينا أن نربح بعضنا./ أنا القبلة التي ارتجفت في الهواء،/ كأنها تذكّرت فجأةً/ أنَّ الشفاه لا تملك تاريخًا طويلاً في الوفاء./وأنت/ غرستَ سكينك في صدري،/ كمن يُجرّبُ المعنى لا الجريمة،/ كأنك أردت أن تعرف/ هل الألم مادة محسوسة؟/ أم فكرة فقط؟/ لكن السكين لا يفكّر،/ وأنا - لم أمت،/ لكن شيئًا في قلبي توقّف/ عن الاعتراف بالحياة]. وبناءً على ما تقدّم – وهذه محاولة لتنظير عملية إنتاج القصيدة من جانبي وما قامت به الدكتورة د. منى قابل وهي بريئة من ارتكاب جريمة النقد المتخصص براءة ذئب النظريات من دم القصيدة- فإننا نعثر على الانزياح داخل قصيدة (منى قابل) أثناء قيامه بعملية التحرر من إسار المباشرة والسيولة ويحدث هذا على مرحلتين: الأولى بتحطيم القيود المتوارثة والمفروضة على اللغة، متبوعة بعملية قاسية تشتغل على خلخلة المعاني. ومن ثمّ فإن عملية إنتاج النص بدأت بخرق النَّاصة لقواعد اللغة بوعي وخبرة لا اعتباطا؛ لإعادة إنتاج لغة شعرية جديدة لا تشبه أحدًا؛ مع الاحتراس الفائض واليقين بأنّ الانزياحات إذا ما تأصَّلت صارت قواعد صارمة. أمّا في المرحلة الثانية وهي التوجّه نحو الشعرية البلاغية من خلال مستويين: الأول توظيف (الأسلوبية الصوتية)؛ حيث بناء جملة كاملة المعنى محصورة بين وقفتين(DEUXPAUSES) فيكون الوقف حيث يتم المعنى.ثم المستوى الدلالي، الذي يرتكز على (الإسناد) وهو عملية التركيب داخل الجملة، و تحكمها ضوابط تتدرج من الفونيم إلى الألفاظ إلى الجمل ثم الربط بين الجمل، حيث تتنامى حرية التركيب متوازية مع هذا التدرج؛ ومن نماذجه نقرأ معها:[ما تبقّى،/ قصيدةٌ رفضت اللغةُ أن تمضغها،/ رعشةٌ لا نعرف: هل هي من الحبّ أم من انقطاعه؟/ ندبةٌ في الصوت،/ وصمتٌ/ أثقل من أي كلام./ بحثت، صدّقني،/ عن تفسيرٍ منطقي للغياب،/ عن خارطة تمحوك من تضاريس جسدي،/ عن دواء يُنقّي الذاكرة/ من براءة عينيك/ فلم أجد،/ إلا المزيد من الأسئلة]. وهنا أسوق المثال على التقطيع القصدي للجمل المتناثرة داخل النص والذي يوضح لنا مدى قدرة د. منى قابل على اللعب على ثيمة الإسناد وهي لُبُّ الوحدة العضوية التي لاتتوفر كثيرا في قصائد شعراء جيلها من النثريين والتفعيليين، والعموديين، والشكلانيين والتجريبيين، والصامتين، والزاعقين واللاهثين وراء بقعة ضوء في نهاية النفق والنائمين على وجع القصيدة. وفي هذا المقطع تُجبرنا منى قابل على اللهاث خلفها.. فهيَّا: [(ما علينا)/قل لي،/ هل للورد ذاكرة؟/ هل سيتذكّر أنها ليست أنا؟/ وأنني أنا/ من شرحتُ لك سرّ عطره،/ حين قلت لك:/ إن الوردة لا تُهدى/ بل تُفهم./ كيف ستُعلّمها/ أن تقول: "يا ربي!"/ ليس تعجّبًا،/ بل خشوعًا أمام عينيك؟/ وكيف ستقنعها/ بأن البومة لا تُخيف،/ بل تحاور/ وأن الغراب، في فلسفة الأرواح،/ رسول منسيّ؟/ والأهم/ كيف ستخبرها/ بالطريقة التي علمتُك فيها/ أن "أحبك"/ ليست وعدًا،/ بل سؤالًا أبديًا/ عن الوجود،/ نطرحه على من نُحب،/ كل ليلة،/ ولا ننتظر الإجابة./ أنا أحبك/ وهذا/ ما تبقّى مني./ وهذا ربما، هو كلّ ما كنته]. وفي الأخير أقول لكم: لدي اعتقاد أن قصيدة (ما تبقى من الفراق) للدكتورة منى قابل قصيدة نثر مسموعة بامتياز وأن قراءتها صمتا لا تُحقق متعة الالتذاذ بالفكرة، وتحت ظلال خفوت القراءة الصامتة يسقط الإيقاع وتهرب الكثير من المعاني من شرك المجاز |
| المشـاهدات 239 تاريخ الإضافـة 16/08/2025 رقم المحتوى 65716 |
 أخبار مشـابهة
أخبار مشـابهة |
 الاخراج المسرحي في الدراما الشعائرية الدينية / د.سنان العزاوي الاخراج المسرحي في الدراما الشعائرية الدينية / د.سنان العزاوي
|
 |
 قصة الحالمات الأفغانيات الحقيقية دراما ملهمة بطلاتها فتيات موهوبات
كاسرات القواعد.. احتفاء بالشجاعة والتحدي للمرأة الأفغانية قصة الحالمات الأفغانيات الحقيقية دراما ملهمة بطلاتها فتيات موهوبات
كاسرات القواعد.. احتفاء بالشجاعة والتحدي للمرأة الأفغانية |
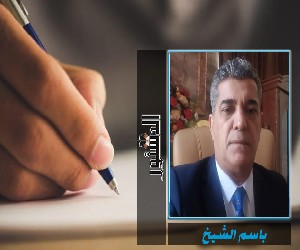 |
 الاستبعاد.. تشذيب القوائم أم تقليمها؟ الاستبعاد.. تشذيب القوائم أم تقليمها؟
|
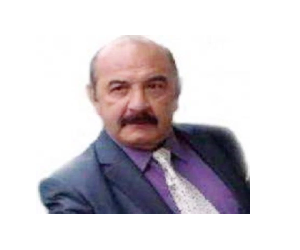 |
 قضية الراحلة د. بان من زاويةٍ اخرى .! قضية الراحلة د. بان من زاويةٍ اخرى .! |
 |
 لتسهيل التجارة ومكافحة الفساد.. الجمارك تشرع بربط شركات الطيران بنظام الأسيكودا لتسهيل التجارة ومكافحة الفساد.. الجمارك تشرع بربط شركات الطيران بنظام الأسيكودا
|
 توقيـت بغداد
توقيـت بغداد 


