 ميتافيزيقا الأشياء اليومية
في ديوان "أنت لا تخصني وأنا لا أخصك"
ميتافيزيقا الأشياء اليومية
في ديوان "أنت لا تخصني وأنا لا أخصك" |
| ميتافيزيقا الأشياء اليومية في ديوان "أنت لا تخصني وأنا لا أخصك" |
  
|
 فنارات فنارات |
 أضيف بواسـطة addustor أضيف بواسـطة addustor |
 الكاتب الكاتب |
| النـص :
للشاعر مؤمن سمير ناظم ناصر القريشي
مقدمة: عالَمٌ موازٍ في تفاصيل صغيرة ديوان مؤمن سمير "أنت لا تخصني وأنا لا أخصك"، دار "الأدهم"-مصر2024،ليس مجرد نصوص شعرية، بل هو عالَمٌ موازٍ تُعاد فيه صياغة الوجود من خلال أدق تفاصيله: بَابٌ يَئِنُّ، نافذةٌ تتنفَّس، ذاكرةٌ تتحوّل إلى كائنٍ طفيليّ. هنا لا يصف الشاعر الحياة بل يخلق بديلاً لها عبر "ميتافيزيقا الأشياء اليومية"، حيث يُسقط الأسئلة الوجودية الكبرى على التفاصيل العابرة التي نهملها في حياتنا اليومية. هذا الديوان هو استعاضة أنطولوجية (وجودية) عن واقعٍ مُعطَّب بالغياب والنسيان. .1الأنطولوجيا اللامركزية: حين تتحوّل الأشياء إلى أرواحٍ واعية يسعى الديوان إلى تفكيك المركزية البشرية للوجود، لينتقل بالوعي من الذات الإنسانية إلى العالم المحيط بها. فالباب ليس خشباً ومفصلات، بل هو كائنٌ يختزن الزمن": البابُ شبحٌ يثقل النظرات، البابُ ريحٌ تخفف الكثافة". وهو ليس مجرد عنصر معماري، بل حارسٌ للعتبات بين العوالم: الواقع والحلم، الداخل والخارج، الحياة والموت. وتمتد هذه الروح إلى كل تفصيل: "الطُرقَة التي كانت تتضاءل كلما تضاءلنا رأيتها اليوم تعدو". فالمكان هنا كائن حي يتنفس بتنفسنا، يتضاءل حين نتضاءل ويتمدد حين نتمدد. حتى الكلب في القصيدة يخضع لهذا الانزياح الوجودي، من كائنٍ يُربط إلى استعارةٍ للإنسان المسحوق: "أنا كلب العالم الجديد... يربطوني على باب المخزن إذ ربما يفزع اللصوص، لكني أموت في كل مرة". هذه "الأنطولوجيا اللامركزية" هي جوهر رؤية الديوان: الوجود لا يقتصر على الإنسان، بل البيت بأكمله، بعناصره الصغيرة، يشكّل شبكة من الوجودات الواعية التي تشاركنا أفراحنا وأتراحنا. 2.الذات المتشظية: الذاكرة الطفيلية وأنداد بيسوا إذا كانت الأشياء تتحول إلى كائنات واعية، فإن الذات الإنسانية نفسها تتشظى إلى أنداد وأقنعة. الذاكرة هنا ليست أرشيفاً، بل كائن طفيلي يعيش فينا ويتغذى علينا: "أيقنتُ أنني أحب كونها حرة كالهواء، تستِّف ما يحلو لها فقط وهي تصفر بكل سعادة". إنها تمنحنا "حياة بديلة" لكن بثمن باهظ: استيلاؤها على حاضرنا وتشكيله على مقاس ماضٍ انتقائي. وهذا الاستيلاء يبدأ من الطفولة التي لا تظهر كبراءة، بل كلحظة تأسيس للجحيم": كنتُ ساعتها صغيراً والنار كانت صغيرة تكبر رويداً رويداً وتلسع أقدامنا". الذاكرة الطفولية لا تذكر، بل تعيد إنتاج الألم. لا عجب أن تتحول الذات إلى "متحف لأندادها"، كما في حوار الشاعر مع شبح بيسوا": أنا مملوء بأندادي وثقتي بنفسي تبدو زائدة... لكني أتوقُ إليَّ خفيفاً". الهوية هنا ليست جوهراً ثابتاً، بل نتاج تفاوض دائم بين الأقنعة التي نرتديها والأشباح التي تسكننا. 3.آليات الخلق: اللغة المتحركة والشفرة الإبداعية اللغة المتحركة: الانزياح البيولوجي والديناميكي للكلمات في ديوان مؤمن سمير، تتحول اللغة من أداة توصيل إلى كائن حي، من خلال الآليات التالية: • التجسيد البيولوجي: تتحول المشاعر المجردة إلى أعضاء ملموسة. عبارة "إصبعي خجول" تنقل الوعي من الذات إلى جزء منها، محولةً الخجل إلى عجز فيزيائي عن الفعل، مما يجعل اللغة تُحسّ قبل أن تُفهم. • الحركة العفوية: تخضع اللغة لقوانين الطبيعة لا لإرادة الشاعر. الجملة لا تُبنى،" بل تُسقَط" يحوّل الكتابة من صناعة إلى ظاهرة طبيعية، حيث للكلمات جاذبيتها الخاصة ومسار سقوطها غير المُتحكَّم به. • التحول الدلالي المستمر: الكلمات كيانات سائلة غير مستقرة. كلمة "النافذة" تهاجر من دلالة مكانية (نافذة الغرفة) إلى نفسية (نافذة القلب) ثم إلى وجودية (نافذة الصبح)، مما يخلق شاعرية ديناميكية تجبر القارئ على مطاردة المعنى المتشكل بدلاً من التقاطه ثابتاً. • الموسيقى المتشظية: الإيقاع لا يتبع الوزن التقليدي، بل إيقاع النفس المتقطع والقلق الوجودي. انعدام انتظام علامات الترقيم وتبادل الجمل القصيرة والطويلة (مثل: "وهم يسقطون من جيوبي بلا يَدٍ تسندهم ولا ظل") يخلق نغماً داخلياً يعبّر عن حالة اللااستقرار. الشفرة الإبداعية: النظام السري الحاكم لعالم الديوان الشفرة الإبداعية هي الدستور غير المرئي الذي ينظم حركة اللغة ويحكم علاقات العناصر الشعرية، ويتجلى في: • قاعدة الانزياح الوجودي: الاستعارة ليست للتشبيه بل للاستبدال الكلي. ترفض الشفرة المقارنة ("أشعر كالكلب") وتفرض الانزياح الأنطولوجي ("أنا كلب"). هذه القاعدة تسمح بخلق استعارات جذرية تشكل لبنات العالم البديل. • قاعدة التحويل والتداعي: تسمح الشفرة لأي عنصر (كلمة، صورة، ذكرى) بالتحول إلى عنصر آخر وفق منطق التداعي الحر واللاوعي، لا المنطق السببي. هذا هو أساس تحول "النافذة" إلى "قلب" وإلى "صبح"، في عملية تشبه خوارزمية حلمية. • قاعدة التماسك العضوي (اللاتماسك): التماسك لا يُفرض من خارج النص، بل ينبثق من داخله. القصيدة تبنى عبر توازن القصاصات، حيث يتماسك النص من خلال التناغم الخفي بين أجزائه المتشظية، لا عبر التسلسل المنطقي. • قاعدة الصمت النشط: اللاّمقول مساوٍ للمقول في الأهمية: الصمت ليس فراغاً بل مساحة دلالية مكثفة. القصيدة لا تُقرأ فقط، بل "تُستمع إلى صمتها"، مما يجعل القارئ شريكاً في فك الشفرة وإكمال دوائر المعنى.
4.قراءات متعددة: فك الشفرة عبر الحواس القراءة التشكيلية (البصرية): النص كلوحة تشكيلية الديوان ليس مجموعة كلمات، بل هو معرض فني بصر: • التشكيل على الصفحة: تقطيع الأشطر والفراغات يصنع لوحة تجريدية، تجعل القصيدة تُرى كما تُقرأ. • الصور الجاهزة: صور مثل ذبائح خضراء، إصبعي خجول… في فراشة تفر، الطرقة التي تتضاءل تتحول إلى لوحات ذهنية بألوان وأشكال متناقضة. • التجريد والنحت: اللغة تنحت المشاعر بدل أن تصفها، فتحوّل الوحدة إلى صمت يثقل، والألم إلى أشباح تسقط. القراءة الموسيقية: سيمفونية الصمت والكسر إيقاع الديوان هو موسيقى داخلية تعبر عن حالة الوجود المتشظي. • موسيقى الكسر: إيقاع النفس المتقطع ودقات القلب المضطربة، حيث التقطيع المفاجئ للجمل يشبه ارتجال الجاز وكسر الإيقاع المتوقع. • موسيقى الصمت: الفراغات والوقفات غير المنتظمة تتحول إلى مقامات صامتة تحمل دلالة مكثفة، فالنص يعزف بالصمت كما بالكلام. • التوزيع الآلي: لكل عنصر نغمة خاصة؛ الذاكرة صافرة طائشة، الكلب نغمة كئيبة منخفضة، النار نغمة حادة متصاعدة، فيما القارئ هو قائد الأوركسترا الذي يوحّد هذا التنوع. القراءة السينمائية: مونتاج الذاكرة والمشاهد المتقاطعة الديوان فيلم سينمائي مكتوب، يستخدم تقنيات المونتاج ببراعة. • القفز بين اللقطات: النص ينتقل فجأة بين الأزمنة (من طفولة النار الصغيرة إلى حاضر الكلب المهين) ليخلق تشظيًا وانزياحًا زمنياً. • اللقطة المقربة: تركيز مكثف على تفاصيل صغيرة (الإصبع الخجول، الخل في الذبائح الخضراء) يحوّلها إلى أحداث درامية كبيرة. • المونتاج الموازي: تقاطع مشاهد الذاكرة والحلم والواقع القاسي يضاعف التوتر الدرامي ويكشف تعدد مستويات التجربة. • اللقطات الرمزية: صور مثل الباب الشبح والذبائح الخضراء والطرقة التي تعدو تعمل كلقطات بصرية مكثفة من فيلم وجودي طويل. خاتمة: استعاضة أنطولوجية يقدم مؤمن سمير في ديوانه ما يمكن تسميته "استعاضة أنطولوجية". ففي مواجهة واقع إنساني مُعطّب بالغياب والقهر والنسيان، لا يكتفي الشعر بالتعويض، بل يخلق عالماً موازياً مكتمل الأركان: ذاكرة طفيلية خلاقة، أشياء واعية، لغة حية، وجود متشظٍّ لكنه حقيقي. ومن هنا تأتي مفارقة العنوان: "أنت لا تخصني وأنا لا أخصك". فالعالم الذي يبنيه الشاعر يستقل عن صاحبه وقارئه، لكن هذا الاستقلال بالضبط هو ما يمنحنا تأشيرة دخول إليه. هو عالم لا يخص أحداً لأنه يخص الكل. الشعر هنا ليس ترفاً جمالياً، بل ضرورة وجودية للنجاة من برودة الواقع، وشهادة على أن الجمرة الخامدة لا تزال قادرة على الإحراق. |
| المشـاهدات 24 تاريخ الإضافـة 19/10/2025 رقم المحتوى 67501 |
 أخبار مشـابهة
أخبار مشـابهة جريدة الدستور ليوم الاثنين 20/10/2025 للعدد 6306 جريدة الدستور ليوم الاثنين 20/10/2025 للعدد 6306 |
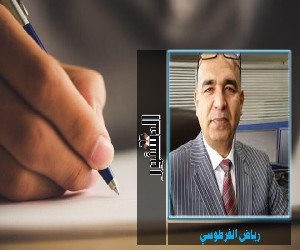 |
 الطاقة بوصفها حروباً وسلاماً الطاقة بوصفها حروباً وسلاماً
|
 |
 مجال الكوميديا ليس مجالا آنيا ولا يمنح الشهرة سريعا
إحسان دعدوش: بحجة الكوميديا استبعدت عن الدراما مجال الكوميديا ليس مجالا آنيا ولا يمنح الشهرة سريعا
إحسان دعدوش: بحجة الكوميديا استبعدت عن الدراما |
 |
 ناصرية الابداع تحتفي بالقاص عبد الكريم السامر من اعلام السرد القصصي القصير ناصرية الابداع تحتفي بالقاص عبد الكريم السامر من اعلام السرد القصصي القصير |
 |
 رسالة إلى السيد مقتدى الصدر وجماهيره: لا تتركوا الساحة السياسية للعابثين! رسالة إلى السيد مقتدى الصدر وجماهيره: لا تتركوا الساحة السياسية للعابثين! |
 توقيـت بغداد
توقيـت بغداد 


