 التكسير الزمني والتعددية الصوتية في رواية "رأس أنجلة" للروائية التونسية إيناس العباسي
التكسير الزمني والتعددية الصوتية في رواية "رأس أنجلة" للروائية التونسية إيناس العباسي |
| التكسير الزمني والتعددية الصوتية في رواية "رأس أنجلة" للروائية التونسية إيناس العباسي |
  
|
 فنارات فنارات |
 أضيف بواسـطة addustor أضيف بواسـطة addustor |
 الكاتب الكاتب |
| النـص :
مروان ياسين الدليمي
إن موضوعات ;الهجرة ، الهوية ، وما بعد الاستعمار، بعيدًا عن كونها مجرد إطار تنظيمي ،تشكل العمود الفقري للبنية السردية في رواية "رأس أنجلة" للكاتبة التونسية إيناس العباسي والذي يحمل رؤيتها الفنية. وبنية الرواية تتسم بتعقيد واضح يعكس التشتت النفسي والثقافي للشخصيات، معتمدةً بذلك على ;التعددية الصوتية، التكسير الزمني، وتداخل وجهات النظر. هنا يمكن الاشارة إلى ثلاثة عناصر أساسية: التعددية الصوتية وتوزيع الأدوار السردية، التلاعب بالزمن وتأثيره على الحبكة، دور الفجوات السردية في بناء التأثير الدرامي. صدرت رواية "رأس أنجلة "عام 2025 عن دار نوفل/ هاشيت أنطوان، وتتمحور حول قصة شقيقتين تونسيتين، ليندا ونادية، وشاب فرنسي يُدعى فيليب، تتشابك خطوط القصة في نسيج سردي يتداخل فيه الواقع بإشارات تجنح للرمزية. نسيج من وجهات النظر تعتمد "رأس أنجلة" بنية سردية متعددة الأصوات، حيث تُروى القصة من خلال ثلاثة رواة رئيسيين: نادية، التي تهاجر إلى فرنسا، ليندا، التي تتجه شرقًا، وفيليب، الشاب الفرنسي ذو الأصول التونسية. هذا التعدد لا يقتصر على تقديم وجهات نظر مختلفة، بل يُشكّل نسيجًا سرديًا يعكس التشتت الثقافي والوجودي للشخصيات. كل راوٍ يمتلك صوتًا مميزًا يتماشى مع تجربته: نادية تتحدث بلغة مشحونة بالقلق والتمرد، ليندا بلهجة تأملية تحمل نوستالجيا الوطن، وفيليب بأسلوب يعكس الحيرة والبحث عن الهوية. توزع الكاتبة الفصول بين هؤلاء الرواة بشكل غير متساوٍ، مما يخلق ديناميكية سردية متباينة. على سبيل المثال، فصول نادية أكثر كثافة وعددًا، مما يُبرز دورها كمحور درامي، بينما تظهر فصول فيليب متقطعة، كأنها تعكس انقطاعه عن جذوره. هذا التوزيع يُذكّر بما أشار إليه الناقد جيرار جنيت في تحليله للسرد متعدد الأصوات، حيث يُصبح تباين الأصوات وسيلة لتجسيد الصراعات الداخلية والخارجية. في "رأس أنجلة"، التعددية الصوتية لا تُقدم روايات موازية فحسب، بل تخلق حوارًا ضمنيًا بين الشخصيات، حيث تتقاطع تجاربهم رغم انفصال مساراتهم الجغرافية. اللافت أن العباسي تستخدم تقنية "الراوي الثانوي" في بعض الفصول، حيث تُدخل شخصيات هامشية (مثل الأم أو أصدقاء نادية) لتقديم وجهات نظر خارجية. هذه التقنية تُضيف طبقة إضافية من العمق، لأنها تُظهر كيف تُرى الشخصيات الرئيسية في أعين الآخرين، مما يُعزز التوتر بين الذات والهوية الاجتماعي. تلاعب بالزمن التكسير الزمني هو العنصر الأبرز في بنية الرواية، حيث تتجنب العباسي السرد الخطي لصالح بنية مفتتة تتحرك بين الماضي والحاضر،وحتى لمحات مستقبلية رمزية. الرواية لا تبدأ من نقطة زمنية محددة، بل تُلقي القارئ مباشرة في لحظة ذروة: هروب نادية من تهديدات الملثمين. من هنا، تتفرع الأحداث إلى الوراء (ذكريات طفولتها مع الأب القاسي) وإلى الأمام (رحلتها في فرنسا)، مما يخلق إحساسًا بالتدفق غير المستقر. هذا التلاعب بالزمن مستوحى من تقنيات الرواية الحديثة، حيث يُستخدم التكسير ليعكس الاضطراب النفسي. فيُعزز التكسير الزمني موضوع الهجرة، إذ يُشبه التشتت الزمني تشتت المهاجر الذي يعيش بين ماضٍ مؤلم وحاضر غامض. على سبيل المثال، فصول ليندا تتخللها ذكريات متقطعة عن الوطن، تظهر كومضات غير مكتملة، مما يُجسّد محاولتها الفاشلة لاستعادة الماضي. تستخدم العباسي تقنية "التكرار الزمني"، حيث تُعاد رواية حدث معين من زوايا مختلفة. على سبيل المثال، لحظة هروب نادية تُروى من منظورها المليء بالرعب، ثم لاحقًا من منظور فيليب الذي يسمع عن الحادثة، مما يُضيف طبقات جديدة لفهم الحدث. هذه التقنية، التي أشار إليها الناقد ميخائيل باختين في سياق السرد متعدد الأصوات، تُعزز الإحساس بالنسبية: لا توجد رواية واحدة "حقيقية"، بل وجهات نظر متشابكة. وهذا الغموض يخدم الرواية فنيًا، إذ يُعكس عدم اليقين الذي يُلازم الشخصيات. الغياب أداة درامية تُشكّل الفجوات السردية عنصرًا حاسمًا في بنية "رأس أنجلة"، حيث تترك العباسي فراغات متعمدة في الرواية تُحفّز القارئ على المشاركة في بناء المعنى. هذه الفجوات تظهر في عدة أشكال، أبرزها غياب التفاصيل حول مصائر بعض الشخصيات. على سبيل المثال، رحلة ليندا شرقًا تُروى بشكل متقطع، مع إغفال وجهتها النهائية أو نتائج بحثها عن الجذور. هذا الغياب يُجسّد رمزيًا استحالة العودة الكاملة إلى الهوية الأصلية. كذلك، تُستخدم الفجوات في قصة فيليب، حيث لا يُكشف عن هوية والده بشكل واضح. الرواية تُلمح إلى إجابات محتملة، لكنها تترك القارئ في حالة تساؤل، مما يعكس حيرة فيليب ذاته. والفجوات تحفز القارئ على ملء الفراغات بتأويلاته الخاصة، مما يجعل القراءة تجربة إبداعية. لاتقتصر الفجوات على الأحداث، بل تمتد إلى الحالة النفسية للشخصيات. فنادية، على سبيل المثال، تُخفي أجزاء من ماضيها حتى عن نفسها، مما يظهر في حواراتها الداخلية المقطعة. هذا الإخفاء يُعزز الإحساس بالصدمة النفسية التي تعانيها، ويجعل القارئ شريكًا في محاولة فهمها. لكن هذه الفجوات قد تُثير إحباط بعض القراء الذين يفضلون رواية أكثر وضوحًا، خاصة في سياق حبكة معقدة أصلًا. بنية تعكس الموضوع ما يجعل البنية السردية في "رأس أنجلة" استثنائية هو التفاعل بين التعددية الصوتية، التكسير الزمني، والفجوات السردية لخدمة الموضوعات المركزية. التعددية الصوتية تُبرز تنوع تجارب الهجرة، حيث تُظهر كيف يعيش كل شخص صراعه بشكل مختلف. التكسير الزمني يُعكس التشتت النفسي والثقافي للمهاجر، بينما تُضيف الفجوات طبقة من الغموض تعزز الإحساس بالاغتراب. تُشكّل هذه العناصر معًا،بنية ديناميكية تُشبه الفسيفساء: كل قطعة تبدو منفصلة، لكنها تتكامل لتشكل صورة كلية عن الإنسان في مواجهة المنفى. تُظهر البنية السردية في "رأس أنجلة" طموحًا فنيًا كبيرًا، حيث تنجح العباسي في بناء عالم سردي يُجسّد تعقيدات الهوية والهجرة. التعددية الصوتية تُضفي ثراءً على الشخصيات، والتكسير الزمني يُعزز العمق السيكولوجي، بينما تُحفّز الفجوات القارئ على التفكير.كما أنها نجحت في أن تبني عالمًا يُجسّد التشتت والصراع الذي يعيشه المهاجر. فهذه البنية لا تُقدم قصة فحسب، بل تجربة تأملية تُحاكي الفوضى الجميلة للحياة ذاتها . استكشاف العمق النفسي يُشكّل الحوار الداخلي واحدًا من أبرز التقنيات السردية في "رأس أنجلة"، حيث تستخدمه العباسي لنقل الحالات النفسية والصراعات الداخلية للشخصيات، خاصة نادية، التي تُعتبر الصوت الأكثر حضورًا. ومن خلال المونولوج، تكشف نادية عن صدماتها الناتجة عن العنف الأسري وتهديدات الملثمين، مما يتيح للقارئ الاقتراب من تجربتها بشكل حميم. على سبيل المثال، في إحدى اللحظات، تتأمل نادية: "كيف أهرب من ظل أبي الذي يطاردني حتى في أحلامي؟ أنا لست أنا، أنا شيء يتشكل في الفراغ." هذه السطور تُظهر كيف يُستخدم المونولوج لتصوير الإحساس بالاغتراب والتمزق. لايقتصر الحوار الداخلي على نادية، بل يمتد إلى ليندا وفيليب، وإن بدرجات متفاوتة. ليندا تستخدمه للتعبير عن نوستالجيا الوطن، كما في تأملاتها عن الطفولة: "كان البيت يحمل رائحة الياسمين، لكن الآن لا أجد سوى الرماد." أما فيليب، فتأتي مونولوجاته مشحونة بالحيرة، كقوله: "هل أنا ابن هذه الأرض أم مجرد زائر يبحث عن سراب؟" هذه التنويعات تُبرز مرونة التقنية في التعبير عن تجارب مختلفة. المونولوج يُعزز العمق السيكولوجي، مما يجعل الشخصيات أكثر واقعية وإنسانية. كما يخدم موضوع الهجرة، إذ يُظهر الصراعات الداخلية التي لا تظهر في الأحداث الخارجية. لكنه قد يُبطئ إيقاع السرد أحيانًا، خاصة عندما يطغى على الحوار الخارجي أو تطور الحبكة، مما قد يُقلل من الديناميكية في بعض الفصول. محاكاة الفوضى الذهنية تعتمد العباسي على التداعي الحر كتقنية سردية لمحاكاة التدفق اللاواعي لأفكار الشخصيات، خاصة في لحظات التوتر أو الأزمات. هذه التقنية، التي اشتهرت في أعمال جيمس جويس وفرجينيا وولف، تسمح بانتقالات سريعة بين الذكريات، المشاعر، والصور الحسية دون ترتيب منطقي واضح. في "رأس أنجلة"، تظهر هذه التقنية بشكل بارز في فصول نادية، كما في مشهد هروبها من الملثمين: "الريح تصرخ، أمي كانت تصرخ، لا، إنه صوتي، أم أنني صامتة؟ رائحة البحر، الملح، دم على يدي، لا، ليس دمًا، إنه المطر." هذا التدفق يُجسّد حالة الذعر والتشوش، مما يُعزز الإحساس بالواقعية النفسية. التداعي الحر يظهر أيضًا في فصول ليندا، لكنه أكثر تأملًا وارتباطًا بالماضي. على سبيل المثال، عندما تمر بقرب البحر، تنتقل أفكارها بين ذكريات الطفولة، رائحة الياسمين، وأحلامها المجهضة، مما يخلق إحساسًا بالتشتت الزمني. أما فيليب، فيُستخدم التداعي الحر بشكل أقل، لكنه فعال في تصوير حيرته، كما في لحظة تأمله في صورة والده: "وجهه غريب، عيناه مثل عيني، أم أنني أتخيل؟ تونس، باريس، لا مكان لي." التداعي الحر يُعزز الطابع الحديث للرواية، إذ يُحاكي الفوضى الذهنية التي تصاحب تجربة الهجرة. كما يُسهم في ربط الماضي بالحاضر، مما يدعم البنية غير الخطية. لكن كثافته قد تُصعّب متابعة القارئ، خاصة في المشاهد التي تتطلب وضوحًا لفهم الأحداث. مع ذلك، تُظهر العباسي مهارة في التوازن بين التداعي والسرد المنظم، مما يحافظ على تماسك النص. لغة الرمز والصورة تُعَدّ اللغة الشاعرية إحدى أقوى التقنيات في "رأس أنجلة"، تستخدم الكاتبة الوصف الشاعري ليس فقط لتصوير الأماكن والأحداث، بل لخلق صور رمزية. على سبيل المثال، تصف البحر بأنه "وحش نائم يتنفس تحت النجوم، ينتظر لحظة ليبتلع الأحلام." هذه الصورة لا تُقدم البحر كمشهد طبيعي فحسب، بل كرمز للمخاطر والإغراءات التي تواجه المهاجرين. الوصف الشاعري يتجلى أيضًا في تصوير الحالات النفسية. عندما تُعاني نادية من الخوف، تُوصف حالتها بأنها "كأن قلبها طائر محبوس في قفص من زجاج يكاد ينكسر." هذه الاستعارة تُضفي بعداً حسياً على تجربتها، مما يجعل القارئ يشعر بالتوتر ذاته. بالنسبة إلى ليندا، تُستخدم الشاعرية لتصوير الوطن كذاكرة مفقودة: "تونس ليست أرضًا، إنها لحن عالق في حلقي لا أستطيع غناءه." أما فيليب، فتأتي أوصافه أكثر تجريدًا، كقوله: "أنا ظل يبحث عن جسد لم يعرفه قط." الوصف الشاعري يُثري النص جماليًا ويُعزز الرمزية، مما يجعل الرواية أقرب إلى التجربة الشعرية منها إلى السرد التقليدي. كما يُسهم في ربط الأحداث بالمشاعر، مما يعكس الصراع بين الواقع والحلم. تفاعل التقنيات تتفاعل تقنيات التعددية الصوتية والتكسير الزمني لخلق تجربة متكاملة. فالحوار الداخلي يدعم التعددية الصوتية، إذ يمنح كل راوٍ صوتًا فريدًا يعكس تجربته، بينما يُعزز التداعي الحر التكسير الزمني من خلال ربط الماضي بالحاضر في تدفق غير خطي. أما الوصف الشاعري، فيُضفي طبقة رمزية تُبرر الفجوات السردية، إذ يُحوّل الغموض إلى فرصة للتأمل بدلاً من عيب في الحبكة. تُشكّل هذه التقنيات معا نسيجًا سرديًا يُحاكي الفوضى الجميلة لتجربة الهجرة. |
| المشـاهدات 3949 تاريخ الإضافـة 22/06/2025 رقم المحتوى 64144 |
 أخبار مشـابهة
أخبار مشـابهة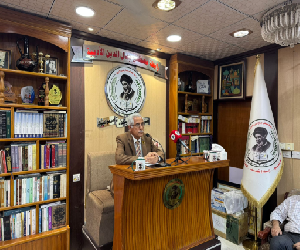 |
 رابطة مصطفى جمال الدين الأدبية بالبصرة تضيف شاعر سوق الشيوخ علي مجبل المليفي رابطة مصطفى جمال الدين الأدبية بالبصرة تضيف شاعر سوق الشيوخ علي مجبل المليفي
|
 |
 مشروع مدينة البصرة الثقافية على طاولة نقاشات قصر الثقافة والفنون في البصرة مشروع مدينة البصرة الثقافية على طاولة نقاشات قصر الثقافة والفنون في البصرة
|
 |
 إبداع وتألق للفرقة الوطنية للتراث الموسيقي العراقي في مهرجان (الإمارات تحب العراق) إبداع وتألق للفرقة الوطنية للتراث الموسيقي العراقي في مهرجان (الإمارات تحب العراق) |
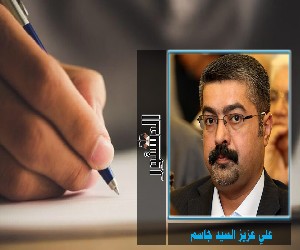 |
 في الهواء الطلق
قدرة الجماهير على التغيير في الهواء الطلق
قدرة الجماهير على التغيير |
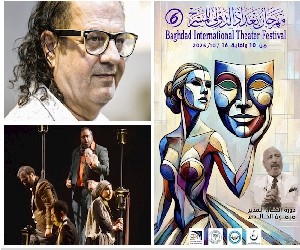 |
 إشادة عراقية بالإرث المسرحي الكويتي تزامناً مع مشاركة غصة عبور في مهرجان بغداد إشادة عراقية بالإرث المسرحي الكويتي تزامناً مع مشاركة غصة عبور في مهرجان بغداد |
 توقيـت بغداد
توقيـت بغداد 


