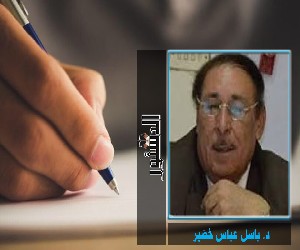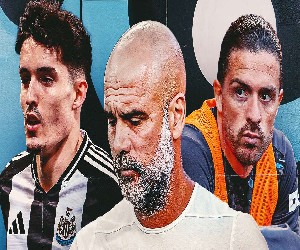كيف نفهم الهزيمة والانتصار؟
كيف نفهم الهزيمة والانتصار؟
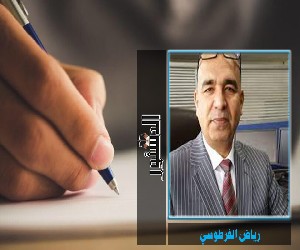 |
| كيف نفهم الهزيمة والانتصار؟ |
  
|
 كتاب الدستور كتاب الدستور |
 أضيف بواسـطة addustor أضيف بواسـطة addustor |
 الكاتب رياض الفرطوسي الكاتب رياض الفرطوسي |
| النـص : الهزيمة ليست صفعةً في وجه التاريخ، بل سؤالٌ طويل، متجذّر، مرّ المذاق، لا يكفّ عن الطرق على أبواب الوعي. والانتصار، في المقابل، ليس ( هلهولة ) ، زغرودةً على شفاه الشعوب، بل امتحان لما بعد الصعود، ومرآة للمآلات.
ولعلّ أصدق ما قيل عن الهزيمة جاء في كتاب لم يخطّه مؤرخ ولا فيلسوف، بل نزل من علُ، محمولًا بالوحي، صارماً في حكمه: "قل هو من عند أنفسكم". بهذه الجملة، لا يترك النص الإلهي للمؤمنين فرصة التنصّل، ولا يفتح لهم باباً للهروب نحو الخارج. حتى في معركةٍ قُتل فيها أحبّ الخلق، وكان العدو أشد بأساً، ظلّ العتاب موجهاً إلى الداخل: أنتم السبب، أنتم الذين أخطأتم. معركة أحد لم تُهزم فيها الأمة بالسيف، بل بالخذلان من داخلها، بالتردد، بالاختلاف، بالعجلة، بالعصيان. ولهذا كانت آيات "أحد" أطول من آيات "بدر". فالنصر يُذكر، أما الهزيمة فتُحلَّل. النصر يُحتفى به، أما الهزيمة فتُدرّس.
لكننا، نحن، لا نحب أن نفهم الهزائم. نحب فقط أن نُغنّيها، أن نُعيد صياغتها بأغلفة من المديح والإنكار والتبرير. حين سقطنا في هزيمة سبعةٍ وستين، وهي الهزيمة التي لم تُبقِ من الكرامة ذيلًا نستر به العورة، خرجت الجماهير تهتف لمن هزمهم. كأن الشعوب عاقبت نفسها على الخيبة بالمزيد من التصفيق. عبد الناصر، الذي جرّ العالم العربي إلى المذبحة، عاد نبياً في شوارع القاهرة ودمشق وبغداد. كان الناس يصرخون: ناصر يا حرية!، بينما كانت الدبابات الإسرائيلية ترسم حدود الخرائط من جديد.
نحن لا نُحسن فهم الهزيمة، لأننا لا نحسن فهم الانتصار. والانتصار، إن لم يُفهم، يُصبح مَطبّاً جديداً. البريطانيون، حين انتصر معهم تشرشل في الحرب العالمية الثانية، شكروا الرجل، ثم أعفوه من الحكم. لماذا؟ لأن الانتصار مرحلة، والحكم مرحلة أخرى، والشعوب الحيّة تعرف الفرق بين من يصلح للمعركة ومن يصلح لبناء السلام. أما نحن، فحين نهزم نحتفل، وحين ننتصر نتهاون.
في ثقافتنا، الحناجر أقوى من العقول، والذاكرة أقصر من لحظة تلفزيونية. يُشيَّع صانع الترفيه وسط الكاميرات والدموع، ويُنسى صانع المعنى في عتمة المقابر، فنبكي على ما يُلهينا، ونتجاهل من حاول أن يُنقذنا. هل رأيت جنازة عالم عربي يُبكي فيها الملايين؟ هل سمعت عن زعيم مثقف بكى الناس لرحيله لأنه علمهم كيف يُفكّرون؟ الاستعراض العاطفي، في وعينا، أهم من الفكرة. والضجيج، أهم من التأمل الذي يصنع الوعي.
الهزيمة، في جوهرها، ثقافة. والانتصار، بدوره، ثقافة. ولا تنهزم الأمم حين تخسر ساحة معركة، بل حين تتعوّد على خسارتها، وحين ترفض أن تُصغي إلى صوت الخطأ. لا تنتصر الأمم بالرصاص، بل بالذاكرة. من لا يقرأ الهزيمة، سيعيد تكرارها كلما فتح عينيه على صباح جديد.
انظر إلى الفيتناميين. شعبٌ طحنته أمريكا بالنار، بالغاز، بالحروب المحرّمة، ومع ذلك، لم يبكِ، لم يصرخ في الشوارع، لم يلعن القدر. جفّفوا أنفاق الصرف الصحي، حوّلوها إلى مدارس، وانتقلوا من تحت الأرض إلى فوقها. عاشوا في جحيمٍ، لكنهم خرجوا منه وهم يحملون كتباً بدل الشعارات، وآلات بناء بدل الحناجر. قرأوا كتب "هوشي منه" كما نقرأ نحن ديواناً شعرياً، لكنهم لم يضعوها تحت الوسادة، بل بنوا بها وطناً. وحين خرجت أمريكا من فيتنام، كانت أمريكا قد خسرت أكثر من سلاح، كانت قد خسرت صورتها، وواجهتها، وقناعتها بالتفوق.
أمّا نحن، فما زلنا نقف على قارعة التاريخ، نحمل الهزيمة في حقيبة، ونعلّق الانتصار على الحائط كصورة تذكارية، لا نجرؤ أن نسأل: لماذا؟ لماذا لم ننتصر رغم كثرة الدم؟ لماذا لم نتعلم رغم كثرة السقوط؟ ولماذا، كلما صرخ أحدنا بالحقيقة، خنقوه بالتصفيق؟
إذا أردنا أن نخرج من هذه الدائرة المغلقة، فعلينا أن نتعلم كيف نفهم الهزيمة. لا أن نبررها، ولا أن نُزيّنها، بل أن نُفكّكها، أن نجلس في حضنها، أن نسمع أسئلتها المؤلمة. فالهزيمة ليست قدراً، بل نتيجة. والانتصار، حين لا يُفهم، يتحوّل إلى وهْم يُلهينا عن الطريق. |
| المشـاهدات 71 تاريخ الإضافـة 12/08/2025 رقم المحتوى 65641 |
 توقيـت بغداد
توقيـت بغداد