 وسط الضوء الأزرق: تفكيك الغربة الرقمية
في قصائد الحاسوب للشاعر د. عارف الساعدي
وسط الضوء الأزرق: تفكيك الغربة الرقمية
في قصائد الحاسوب للشاعر د. عارف الساعدي |
| وسط الضوء الأزرق: تفكيك الغربة الرقمية في قصائد الحاسوب للشاعر د. عارف الساعدي |
  
|
 فنارات فنارات |
 أضيف بواسـطة addustor أضيف بواسـطة addustor |
 الكاتب الكاتب |
| النـص :
ناظم ناصر القريشي
من تمجيد الورق إلى ارتباك الشاشة في زمنٍ تُحفظ فيه القصيدة على "سحابة"، وتُرسل كصورة، كتب عارف الساعدي كتاباً شعرياً بعنوان (قصائد الحاسوب)، لكنه لم يكن يكتب عن الحاسوب، بل عن تفكك الإنسان الحديث أمام آلة تبتلع مشاعره. هذا العمل ليس "ديواناً" بالمفهوم الكلاسيكي، بل نصّ شعري عضوي، تتصاعد فيه المقاطع كخطّ درامي متكامل، وتتكشّف من خلاله أزمة الذات المعاصرة في لحظة رقمية باردة. القصيدة هنا ليست تعبيراً عن شعور فقط، بل رصد لانهيار الحميمي وسط الضوء الأزرق. قصائد الحاسوب ليست كتابًا عن الأدوات الحديثة، بل عن السؤال الأخلاقي: كيف يحافظ الإنسان على إنسانيته وسط عالم رقمي؟ عارف الساعدي لا يكتب عن الحاسوب، بل يكتب الشعر بالحاسوب ضد الحاسوب — وهذه أعقد لعبة لغوية وشعورية مارسها شاعر عربي في العقد الأخير. أولًا: ابتكار شعري في زمن التقنية لا يمكن النظر إلى "قصائد الحاسوب" كديوان عادي يُضيف موضوعًا حديثًا إلى الشعر العربي، بل هو عمل يؤسس لشكل جديد من القصيدة، يربط بين الشعر والتكنولوجيا بطريقة فلسفية وجمالية ونفسية: الموضوع الجديد بنَفَسه الفلسفي: لم يسبق لشاعر عربي أن اقترب من الحاسوب بوصفه شريكًا دراميًا وأخلاقيًا في الحياة اليومية. الحاسوب ليس أداة بل كائن يبتلع الطفولة والصوت الداخلي. الهيكل البنائي: ليس تجميعًا لقصائد منفصلة، بل رحلة شعورية متصاعدة. كل نص لبنة في سردية وجودية متشظية وسط الحضارة الرقمية. جماليات الانمحاء والمحو: فعل "المسح" في قلب التجربة: حذف القصائد والذكريات وملامح الأحباب. كما في قوله: "مسح الحاسوب ذاكرةً كاملةً وغناءً عذبًا وبكاء أميراتْ..." (قصيدة 7) ثانيًا: الشعر بوصفه تأملاً في وسيلته — الميتاشعرية الرقمية لا يكتب عارف الساعدي عن الحاسوب فقط، بل يكتب به ومن داخله، في لعبة ميتاشعرية معقدة تُحوّل أداة الكتابة إلى موضوع للقصيدة ذاتها. بنية القصائد تُحاكي المنشورات الرقمية: قصيرة، متقطعة، تنتهي بـ"ضغطة زر"، ولغتها—رغم بساطتها—تفاجئ بصور شعرية حادة، كما في: "القصيدة تُمسح… كأنك شطبتَ طفولةً أو وجهاً أو بيتًا." هكذا، لا تصبح التقنية مجرد موضوع، بل وسيطاً حاضراً في بنية النص. فالقصيدة تتأمل ذاتها من داخل الشاشة، مدركة هشاشتها الرقمية. وهذا ما يمنح الكتاب طابعه الميتاشعري المتفرّد، حيث يتحوّل الشعر إلى تأمل في وسيلته، لا مجرد تعبير بها. اللغة: من الطين إلى الشاشة يتنقل الديوان بين لغتين: .1 لغة الطين والورق: "كتب الأجداد على الطين وكتبنا نحن على الحاسوب حكايتنا..." (قصيدة 9) هنا تقابل حاد بين تقنيات الذاكرة: الطين بوصفه أثرًا خالدًا، والحاسوب بوصفه ذاكرة آنية تُمحى بـ"ضغطة زر". .2 لغة الشاشة والرمز: "مسح الحاسوب بضغطة زرّ واحدةٍ آلاف الكلماتْ" (قصيدة 8) لغة الديوان تستعيد جماليات "النثر الشعري"، بلغةٍ حوارية ومباشرة، لكنها مشبعة بالصور المركّبة والحنين المكثف. من "آدم الأخير" إلى "قصائد الحاسوب": الغربة الرقمية في زمن الشاشة في "آدم الأخير"، كان الشاعر صوتاً فردياً ناجياً من الطوفان، يبحث عن معنى في العدم. أما في "قصائد الحاسوب"، فالغربة أكثر تعقيداً: لم يَفقد الإنسان العالم، بل فَقَد نفسه فيه. كل شيء يبدو حاضراً—الأسرة، الحي، الذكريات—لكن الذات تظل منفية، غريبة وسط حشد رقمي صامت. "لستُ وحيداً / لكنني ممتلئٌ بالغربة يا الله..." (قصيدة 5) الغربة لم تعد سؤالاً ميتافيزيقياً، بل تحوّلت إلى مأزق حضاري معاصر، حيث يتحوّل الإنسان إلى "رمز"، والعائلة إلى "مجموعة واتساب": "العائلة الآن التمت / لكن في الماسنجر أو في الواتساب" (قصيدة 25) ووسط هذا التحوّل، يتغير حتى اللون: الأزرق الباهت—لون الشاشة والضوء الاصطناعي—يهيمن على المشهد، بينما تغيب الألوان الحسية القديمة مثل "القهوة" و"الحطب"، مؤكداً برودة العالم وانطفاء الحميمي. الموسيقى الداخلية: إيقاع الحزن الرقمي في "قصائد الحاسوب"، تنبع الموسيقى من التكرار والنَّفَس الطويل لا من الوزن؛ نغمة حزينة تتردد كصدى ناي مكسور. إيقاع داخلي يحرّك الألم بهدوء، كما في: "اختفت الأشياء..." "ترثي الوحشة..." (قصيدة 26) القصيدة لا تُغنّي، بل تندب. الذات الشاعرة منفية من داخل البيت، لا خارجه: "البيتُ الدافئُ ممتلئٌ بالأولاد... لكننا منفيّون" (قصيدة 5) حتى العاطفة أصبحت تُدار رقمياً، والبكاء موكول إلى الشاشة: "لن أبكي فهنالك وجهٌ في الشاشة يبكي بدلاً عني" (قصيدة 11) هكذا، تصبح الموسيقى وسيلة لتجسيد الغربة، لا تجميلها. بين الصوت والصدى: الشاعر ككائن رقمي لم يعد الشاعر في قصائد الحاسوب هو المتكلّم الأول، بل صار صدًى رقميًا يتردد داخل شاشة. ما يُقال لا يُسمع، وما يُكتب لا يُجاب عليه. النص لا يُلقى من منبر، بل يُرمى على الحائط الأزرق، في انتظار "تمّت القراءة". الشاعر كملف مفتوح، محفوظ مؤقتاً، يتحرك داخل آلة لا مفر منها، يكتب ليُنسى، ويصرخ بصمت رقمي لا رجع فيه ."الشوق اشتدَّ عليّ الليلة... دخلت الصف الأول... ونسيت أن أخرج من النص" (قصيدة 24) القراءة السينمائية: شعر يتحرك داخل مشهد ثابت يُقرأ "قصائد الحاسوب" كفيلم شعري بلقطة واحدة ثابتة: رجل وحيد أمام شاشة، يكتب ويحذف، يتذكّر وينسى. الحركة لا تقع في المكان، بل في الداخل النفسي. فالأمكنة محدودة: الصالة، السرير، الحاسوب؛ والكاميرا رمزية لا تتحرك. في (قصيدة 6)، يبلغ هذا الثبات ذروته حين يُعدّ الشاعر القهوة لحاسوبه ويأخذه إلى "المستشفى" — مشهد يجمع بين التهكّم والمأساة."ماذا يحتاج الحاسوب صديقي أو ولدي؟ الشحن بطيء؟ غيرت الشاحن في غمضة عين" يُقارب الديوان روح أفلام مثل Her وThe Truman Show، حيث تتحوّل التقنية إلى شريك عاطفي، والعالم إلى مشهد مُراقب. الشاعر هنا ليس ذاتًا مستقلة، بل بطل فيلم داخلي لا يُعرض على أحد، بل فينا جميعًا. استخدام التقنية: من الأداء إلى الانهيار عارف الساعدي لم يكتب قصائد عن الحاسوب فقط، بل كتب القصائد كأنها كُتبت بداخله. بنية المقاطع تشبه المنشورات الرقمية: قصيرة، مباشرة، فيها تعليقٌ خفي. كثير من القصائد تنتهي بـ"ضغطة زر"، وكأن النص مكتوب في واجهة "فيسبوك". اللغة نثرية، لكن مشحونة بصورة شعرية تُولد فجأة، مثل: "القصيدة تُمسح… كأنك شطبتَ طفولةً أو وجهاً أو بيتًا." هذا الاستخدام يخلق تواطؤًا ذكيًا: نحن نقرأ القصائد عبر التقنية ذاتها التي يهاجمها الشاعر، وهو ما يزيد من سخرية الموقف ومرارته. القراءة التشكيلية: العزلة البصرية بين عارف الساعدي وإدوارد هوبر تكشف "قصائد الحاسوب" عن بُعد بصري تتشكّل فيه القصائد لا بالألوان بل بالمحو؛ النص مكتوب على بياض الشاشة، لا الورق، والأبيض فيه ليس ضوءًا بل فراغًا رقمياً بارداً. القصائد لا تُبنى على الحضور، بل على ما يُمحى منها، كأنها لوحات واقعية صامتة. هذا الأثر يتقاطع مع عالم إدوارد هوبر، في لوحات مثل "غرفة في نيويورك" و"نوافذ ليلية"، حيث الألفة تُغلف وحدة عميقة. كذلك في "قصائد الحاسوب"، البيت ممتلئ لكن الروح منفية: "البيتُ الدافئُ ممتلئٌ بالأولاد... لكننا منفيّون جزرٌ تتباعد عن أخرى..." (قصيدة 5) التحوّل الزمني والمفارقة الأسلوبية: من لهجة السرد إلى كتابة الذات ضد الذات يتصاعد البناء في قصائد الحاسوب من الطفولة إلى الأبوة، ومن الطين إلى الزرّ، لا بسرد زمني، بل بتحولات شعورية داخلية تُجسّد محو الذاكرة وذوبان الذات. ما يجعل هذا الكتاب الشعريّ فريدًا هو قدرته على خلق مفارقة أسلوبية جوهرية تكمن في أن الشاعر ينتقد التقنية من داخلها، لا من خارجها؛ يلعن الجهاز ويكتب به في آن. القصائد لا تهاجم الحاسوب، بل تكشف التورط العاطفي فيه، فتصبح مرآة مزدوجة: "أنت تشتم هذا النقّال بهذا النقّال وتلعنه ترثي الوحشة فيما أنت تلوذ وراء النقال وتختبئ" بهذا الشكل، لا يعود النص مجرد مرآة للحاسوب، بل مرآة مزدوجة: واحدة تُظهِر الجهاز، وأخرى تُظهِر الذات وهي تتحوّل أمامه، بين الاعتراف والمقاومة. خاتمة: مرآة الشعر في زمن الزرّ قصائد الحاسوب ليست مرثية للعصر، بل مرآة له. فيها شيء من هوبر، من السينما، ومن الشعر الذي لا يعرف إلى أين يذهب. هي نصّ يُقرأ دفعة واحدة، بصوت واحد، لكنه يتحدث بأسماء كثيرة: الأب، الطفل، المنفي، والمبحر في شاشة لا تنطفئ. |
| المشـاهدات 111 تاريخ الإضافـة 07/09/2025 رقم المحتوى 66414 |
 أخبار مشـابهة
أخبار مشـابهة |
 اختتام فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي
مصر تكرّم الفنان الراحل د. سامي عبد الحميد اختتام فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي
مصر تكرّم الفنان الراحل د. سامي عبد الحميد |
 |
 العراق ومساحات التحرك وسط الصراع في المنطقة. العراق ومساحات التحرك وسط الصراع في المنطقة. |
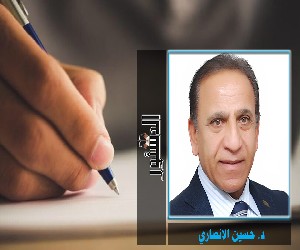 |
 رسالة المصطفى ((ص)) منهج للإصلاح ومحاربة الظلم والفساد. رسالة المصطفى ((ص)) منهج للإصلاح ومحاربة الظلم والفساد.
|
 |
 تفكيك عصابة ابتزاز وتزوير في بابل
الأمن الوطني يطيح بمتهم يدّعي قيادة تحرّك ثوري في واسط تفكيك عصابة ابتزاز وتزوير في بابل
الأمن الوطني يطيح بمتهم يدّعي قيادة تحرّك ثوري في واسط |
 |
 إطلاق مشروع دليل تسجيل المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلكترونيًا إطلاق مشروع دليل تسجيل المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلكترونيًا
|
 توقيـت بغداد
توقيـت بغداد 


