 في العمق
أدباء الخمسين نسخة: صناعة الوهم في زمن الورق المهدور!!
في العمق
أدباء الخمسين نسخة: صناعة الوهم في زمن الورق المهدور!! |
| في العمق أدباء الخمسين نسخة: صناعة الوهم في زمن الورق المهدور!! |
  
|
 فنارات فنارات |
 أضيف بواسـطة addustor أضيف بواسـطة addustor |
 الكاتب الكاتب |
| النـص :
اشارة توضيحية/شوقي كريم حسن
لم يعد النشر الأدبي في المشهد العربي الراهن تعبيراً عن فعل ثقافي يسعى للتواصل مع قارئ حيّ، بقدر ما تحوّل عند كثير من الكتّاب إلى وسيلة لإنتاج اعتراف شكلي أو شهادة مرور إلى مؤسسات واتحادات لا تكترث بالعمق بقدر ما تهتم بوجود “كتاب مطبوع” كشرط شكلي للعضوية. هنا تتجلى ظاهرة ما يمكن تسميته بـ “أدباء الخمسين نسخة”، وهي ظاهرة لم تولد من فراغ، بل صنعتها منظومة ثقافية مرتبكة، وسوق قراءة شبه غائب، ومؤسسات فقدت معاييرها الحقيقية، فانفتح الباب واسعاً أمام من يتعامل مع الكتاب بوصفه بطاقة تعريف اجتماعية أكثر مما هو منتج فكري أو جمالي.الكاتب في هذه الظاهرة لا يرى في نصه مشروعاً للتراكم أو الحوار مع القراء، بل مادة سريعة للطبع في مطبعة رخيصة، بعدد محدود لا يتجاوز الثلاثين أو الخمسين نسخة، سرعان ما تُوزّع على الأصدقاء أو تُقدَّم كهدايا في المقاهي والملتقيات، ثم يُعلن بفخر أن “الطبعة الأولى نفدت”، وكأنه يعيش نشوة النجاح الخادع. هذا السلوك لا يشي إلا برغبة محمومة في تثبيت لقب “روائي” أو “شاعر”، وكأن القيمة الأدبية تقاس بعدد النسخ المطبوعة أو بسرعة نفادها، لا بعمق النص وقدرته على البقاء في ذاكرة القراء.ولعل الأخطر من ذلك أن بعض هؤلاء لا يطبعون من أجل القارئ أصلاً، بل من أجل استيفاء شرط إداري يمنحهم بطاقة اتحاد الأدباء أو عضوية جمعية ثقافية. فالمسألة لا تتعلق بالفعل الإبداعي، بل بالاعتراف المؤسسي؛ الاعتراف الذي تحوّل بدوره إلى سلعة، إذ يكفي أن تمتلك ديواناً رديئاً أو رواية مرتبكة، لتصبح عضواً كامل الحقوق في اتحاد يُفترض أنه يمثل نخبة الكتاب. وبذلك ينقلب المشهد: لم يعد الاتحاد أو الجمعية يختار الأديب لعمله، بل صار الأديب يصطنع عملاً شكلياً لكي ينال بطاقة الاتحاد.هذه الظاهرة تحمل آثاراً بعيدة المدى على الثقافة العربية. أولها تضخم المشهد الأدبي بنصوص لا تُقرأ، ما يخلق “ضجيجاً ورقياً” يغطي على الأعمال الجادة. وثانيها إفقاد القارئ ثقته بالكتاب، إذ يجد نفسه أمام عناوين كثيرة لكنها خاوية، فيبتعد شيئاً فشيئاً عن فعل القراءة . وثالثها تحويل الكتاب من منجز إبداعي إلى أداة للتباهي أو مناسبة اجتماعية، فيفقد الكتاب وظيفته التاريخية كجسر للتواصل والحوار. والأدهى أن هذه النصوص المحدودة لا تدخل التداول التجاري ولا تصل المكتبات العامة، فهي نصوص وُلدت معزولة وتموت في عزلة، لا تترك أثراً في الوعي الجمعي ولا في تاريخ الأدب. ولفهم هذه الظاهرة بعمق، لا بد من النظر إلى السياق التاريخي. فالرواد الذين أسسوا للأدب العربي الحديث كانوا ينشرون أعمالهم في ظروف بالغة الصعوبة، ومع ذلك كان دافعهم الحقيقي هو المتلقي، لذلك نمت أعمالهم وانتشرت وأصبحت مرجعيات. أما الآن، ومع تحوّل النشر إلى صناعة تجارية مرتبطة بدور نشر تبحث عن الربح، ووسط غياب قارئ واسع، صار الكاتب مضطراً أن يمول طباعة عمله بنفسه. لكن بدلاً من أن يواجه هذا التحدي بمزيد من الجدية والبحث عن سبل للنشر النوعي أو الإلكتروني، يختار الطريق السهل: طباعة خمسين نسخة والتصريح الوهمي بأنه يعيش لحظة انتشار. هنا يلتقي فقر البنية التحتية للنشر مع نرجسية الكاتب، لينتج مشهداً بائساً. إن الخطر الحقيقي يكمن في أن هذه الممارسات لا تبقى فردية، بل تتحول إلى نموذج يُحتذى. فالشاب الذي يرى صديقه يحصل على لقب “روائي” بكتاب مطبوع في خمسين نسخة، يعتقد أن الطريق ذاته متاح له، فيتضاعف عدد “الأدباء الورقيين”، ويزداد المشهد تلوثاً بالنصوص غير الناضجة. ومع غياب النقد الجاد القادر على فرز الغث من السمين، تصبح الساحة متخمة بأسماء دون أثر، وسير ذاتية مليئة بالعناوين، لكنها عناوين لا يقرؤها أحد. نحن نعيش عصر “المؤلف دونما قارئ”، حيث يتحقق وجود الكتاب بالورق فقط، لا بالقراءة.وإذا كان ثمة مخرج من هذه الظاهرة، فهو لا يكون إلا عبر إعادة الاعتبار إلى المعايير الثقافية. فالاتحادات والجمعيات ينبغي أن تعيد النظر في شروط العضوية، بحيث لا تُمنح لمجرد وجود كتاب مطبوع، بل لقيمة النص وانتشاره الفعلي. ودور النشر مطالبة بأن تتحمل مسؤوليتها الثقافية، فلا تفتح أبوابها لكل من يملك أجرة الطباعة،دون ان تضع معايير تحريرية حقيقية. والنقد الأدبي يجب أن يستعيد دوره في الفرز والتشخيص، لا أن يظل صامتاً أمام سيل النصوص. أما الكاتب فعليه أن يسائل نفسه: هل يكتب من أجل ورقة عضوية أو لقب اجتماعي، أم من أجل أن يدخل نصه في حوار مع العالم؟ إن “أدباء الخمسين نسخة” ليسوا مجرد أفراد يفتقرون للموهبة أو للقراء، بل انعكاس لأزمة ثقافية عميقة يعيشها واقعنا العربي: أزمة قراءة، وأزمة مؤسسات، وأزمة وعي بالكتابة ذاتها. ولعل أشد ما يوجع أن يتحول الكتاب، الذي كان على مدى قرون وعياً وحلماً وخزانة للذاكرة الإنسانية، إلى سلعة شكلية تتكاثر بلا أثر. هنا، في هذا الانحدار، نفقد ليس فقط القارئ، بل نفقد معنى الأدب ذاته.في الوقت الذي تُطبع آلاف النسخ من رواية جديدة لكاتب في أوروبا أو أميركا أو أميركا اللاتينية، وتُترجم إلى لغات أخرى في غضون عام أو عامين، نرى في المشهد العربي جيلاً من الكتّاب يكتفي بخمسين نسخة يطبعها على عجل، ثم يعلن بانتصار وهمي أن “الطبعة الأولى نفدت”، وكأن النشر غاية في ذاته لا وسيلة للوصول إلى القارئ. هنا تتكشف المفارقة: هناك أدب يسعى للخلود عبر التراكم، وهناك أدب لا يتجاوز حدود الرف العائلي أو المقهى المحلي.في التجارب العالمية، تُدار صناعة النشر وفق آليات احترافية صارمة. دار النشر لا تطبع إلا ما تؤمن بجدواه السوقية والثقافية معاً، فالقيمة والجودة شرط مسبق، وليس مجرد قدرة الكاتب على دفع تكاليف الطباعة. الناشر في تلك التجارب أول قارئ وأول ناقد، يقرر إن كان النص يستحق دخول سوق الكتاب أم لا. ولذا، فإن مجرد صدور كتاب جديد هناك يعد شهادة غير مباشرة بجدارة النص، بينما في واقعنا العربي صار كل من يملك المال قادراً على أن يضيف لقب “روائي” أو “شاعر” إلى سيرته الذاتية.ولعل المقارنة الأبرز تكمن في أميركا اللاتينية التي تشبهنا من حيث الفقر والتحديات الاجتماعية، لكنها أنجبت عمالقة مثل غابرييل غارسيا ماركيز وماريو بارغاس يوسا. هؤلاء لم يدخلوا التاريخ بخمسين نسخة، بل بكتب وجدت قارئاً حقيقياً، وخلقت حركة نقدية موازية. المتلقي هناك شريكاً في صناعة الأدب، أما هنا فالمتلقي غائب أو مُغَيَّب، ولذلك صار الكاتب يكتب لنفسه أو لمؤسسة تمنحه اعترافاً شكلياً.في السياق العربي ، لو عدنا إلى جيل الرواد في مصر والعراق ولبنان والمغرب، لوجدنا أن أعمالهم – رغم محدودية الطباعة آنذاك – كانت تسعى للتوزيع والانتشار الحقيقي. نجيب محفوظ لم يُعرف لأنه طبع مئة نسخة من “زقاق المدق”، بل لأنه دخل في معركة حقيقية مع المتلقي، فصارت نصوصه تُتداول وتُناقش وتتحول إلى جزء من المخيال الجمعي. بدر شاكر السياب لم يطبع دواوينه ليضعها في أدراج الأصدقاء، بل ليدخل بها معركة التجديد الشعري. الفارق الجوهري أن الرواد كانوا يبحثون عن قارئ، أما “أدباء الخمسين نسخة” فيبحثون عن لقب أو بطاقة أو صورة تذكارية. وإذا تجاوزنا السياق العربي إلى تجارب حديثة مثل الهند، نجد أن الطباعة الذاتية ، موجودة هناك ، لكن بوعي مختلف. فالكاتب الذي يطبع على نفقته الخاصة يسعى لتسويق كتابه رقمياً وورقياً، ويجتهد لإيصاله إلى منصات القراءة، بل ويدفع للنقاد والمدونين ليكتبوا عنه، فيخلق لنفسه دائرة من القراء الحقيقيين. أما عندنا فالنشر الذاتي غالباً ما ينتهي عند لحظة إخراج الكتاب من المطبعة، ليدخل الكاتب في نشوة الإعلان عن “نفاد الطبعة الأولى”، دون أي جهد لاحقاً لإيجاد قارئ واحد خارج دائرة الأصدقاء.إن خطورة هذه الظاهرة لا تقتصر على الأفراد، بل تخلق “ثقافة بديلة” تجعل الكاتب الجاد في عزلة. حين تفيض المهرجانات والاتحادات بأسماء طبعوا كتبهم بخمسين نسخة، لان الكاتب الحقيقي يشعر أنه يسبح ضد تيار ضخم من الضجيج، ويصير عليه أن يثبت جدارته في وسط موبوء بالرداءة. ومع مرور الوقت، قد يستسلم المتلقي نفسه ويقرر أن الأدب لم يعد يعني شيئاً، وأنه محض لعبة أسماء وعناوين.إذاً، المقارنة بين التجارب ليست لإظهار ضعفنا ، بل للكشف عن السبب الجوهري: في كل مكان حيث توجد سوق قراءة حقيقية، يصبح الكاتب مضطراً أن يكون جاداً، لأن المتلقي هو الحكم الأخير. أما في بيئة دون قراء، فيكفي الكاتب أن يقنع نفسه بأن خمسين نسخة تمنحه الخلود. نحن إذاً أمام أزمة قراءة قبل أن نكون أمام أزمة كتابة.المطلوب اليوم إعادة الاعتبار إلى وظيفة الكتاب بوصفه أداة للمعرفة والجمال، لا بوصفه سلعة اجتماعية أو جواز مرور مؤسسي. إن الاتحادات الأدبية مطالبة بأن تنهي عهد “العضوية الورقية”، وأن تجعل معيارها القيمة الفعلية للعمل وانتشاره. ودور النشر مطالبة بأن تتخلى عن منطق “الزبون الذي يدفع”، وتتبنى منطق “الكاتب الذي يستحق”. والنقد الأدبي، الذي غاب أو غُيِّب، لا بد أن يعود بقوة ليكشف هذه الظواهر ويضعها تحت المجهر.عندها يمكن أن نحدّ من صناعة الأوهام، وأن نستعيد الأدب بوصفه فعلاً إنسانياً حقيقياً، لا لعبة خمسين نسخة تنطفئ في صمت. |
| المشـاهدات 109 تاريخ الإضافـة 07/09/2025 رقم المحتوى 66415 |
 أخبار مشـابهة
أخبار مشـابهة |
 عماد ناصر ينال درجة ماجستير تنفيذي في الإدارة الرياضية من الأولمبية عماد ناصر ينال درجة ماجستير تنفيذي في الإدارة الرياضية من الأولمبية
|
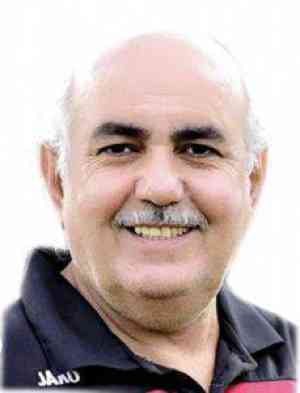 |
 فئات عمرية ..بعيدا عن صناعة الشو ! فئات عمرية ..بعيدا عن صناعة الشو !
|
 |
 طالب بأطلاق شبكة للتضامن مع القضايا العادلة وفي مقدمتها فلسطين
العراق يترأس الاجتماع الاول لتأسيس المجلس البرلماني الآسيوي الافريقي طالب بأطلاق شبكة للتضامن مع القضايا العادلة وفي مقدمتها فلسطين
العراق يترأس الاجتماع الاول لتأسيس المجلس البرلماني الآسيوي الافريقي |
 |
 وزير الإعمار: تسهيلات واسعة للمستثمرين في مجالَي الصناعة والإعمار وزير الإعمار: تسهيلات واسعة للمستثمرين في مجالَي الصناعة والإعمار
|
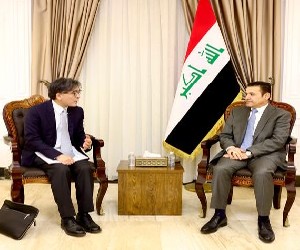 |
 الاعرجي يبحث مع السفير الياباني تطوير القدرات البشرية والعلاقات التجارية الاعرجي يبحث مع السفير الياباني تطوير القدرات البشرية والعلاقات التجارية
|
 توقيـت بغداد
توقيـت بغداد 


