 مرثية جيلٍ ومدينة
قراءة في قصيدة "بغداد" لحسين نهابة
مرثية جيلٍ ومدينة
قراءة في قصيدة "بغداد" لحسين نهابة |
| مرثية جيلٍ ومدينة قراءة في قصيدة "بغداد" لحسين نهابة |
  
|
 فنارات فنارات |
 أضيف بواسـطة addustor أضيف بواسـطة addustor |
 الكاتب الكاتب |
| النـص :
محمد علي محيي الدين صدر ديوان "طقوس ما بعد الأربعين" للشاعر العراقي حسين نهابة عن دار "شهريار" في البصرة سنة 2023، متضمنًا مجموعة من القصائد التي تنبض بوجع الجيل وهموم المكان. وفي قصيدة بعنوان "بغداد"، يتجلى النص بوصفه مرآة لانكسار الذات وانهيار المدينة، إذ يُعيد الشاعر صياغة العلاقة بين العاشق والمعشوقة، بين المنفي والمدى، بين الشاهد والمذبوح. بغداد كما لم تُرَ من قبل في هذه القصيدة، لا تظهر بغداد بوصفها مكانًا خارجيًا، بل باعتبارها كيانًا أنثويًا مركبًا، تتسرب منه الاستعارات والرموز الكثيفة. فـ"عيناكِ" التي تتكرر كمفتتحٍ للعديد من المقاطع، تُصبح مجازًا للمدينة وللحنين والحسرة معًا: عيناكِ ما خُلقا لدموعِ خَيبةٍ بَديلة، ولا لقدرٍ آبق في زَمنٍ مُستعار، عيناكِ لهفةُ مَحروم، تَكالبتْ عليه ذئابُ ذكريات... المدينة هنا ليست مجرد جغرافيا للذكريات، بل جسدٌ مثقل بارتجاجات الماضي والمستقبل، عيونها نشيد مثقل بأعباء العطش، وواحة عذراء، ومزنة لا ترتوي، وسفن معذبة، وصلوات تجرّد الفصول من مواسمها. هذه الصور المتتابعة تخلق لوحة شعرية مشبعة بالتوتر الوجداني، تنوس بين الحب والخذلان، بين الوله والغربة. الانتماء المجروح والهوية المُنتهكة ليست القصيدة رثاءً لبغداد فقط، بل لذات الشاعر أيضًا، بل لجيل بأكمله وُلد على شفا التحولات الكبرى في التاريخ العراقي. ففي المقطع الأهم من النص، يتحول السؤال من تأمل حال المدينة إلى مواجهة الذات: هل أرثي ابنةَ الخوفَ التي ما اعتادت الانتكاس؟ أم لبعضي الأربعيني المُنتهك بلهاثِ انسدال العمر والأرض؟ هنا تتجسد الهوية المكسورة لجيل الأربعين، الذين عاشوا أطوار التبدد، وخرجوا من الحروب والمنافي والإخفاقات الوطنية بشيء من التعب العظيم، وحنين لا يبرأ. نص "بغداد" يُكتب بشاعرية عالية، حيث تمتزج بلاغة الصورة مع نثرية تتقصد التوهج الداخلي لا التفعيلة الخارجية. فالتكرار البنائي لعبارات مثل "عيناكِ" و"عبثًا"، يخلق إيقاعًا داخليًا يُشبه تلاوة مرثية أو نشيد عزاء. أما الصور، فهي استعارات مركّبة تحمل طابعًا بصريًا وفكريًا معًا: "المرايا في حضرتك عدم"، "صفصافة معطلة"، "شوارع تغص بضعفي"، "رؤوس مصلوبة على مناسك الصبر". كل صورة في هذا السياق ليست للزينة أو البلاغة، بل لتأثيث عالم شعري يُعيد بناء العلاقة بين اللغة والتجربة. والقصيدة تضع المتلقي أمام نص داخلي، يُنذرنا بأن ما نحبه قد يكون أيضًا ما يوجعنا، وأن الأماكن التي نرثيها كثيرًا ما تكون أقنعةً للذات المتألمة. في قصيدة "بغداد"، نجد مدينةً مشتهاة، متمردة، ضائعة، لكنها حاضرة بكل وجعها في مفاصل الشاعر وفي قلب القصيدة. إنها مرثية لا تنتهي بموت، بل بعتبٍ دائم، وحنين لا يُشفى، وأمل يُشبه الرماد. أما شاعرها حسين نهابه فقد ولد في مدينة الحلة، وعلى ضفاف الفرات في الرابع عشر من تشرين الأول عام 1966، وما لبث أن حملت روحه منذ صباه توقًا إلى الكلمة، وتمردًا على الصمت، فشق دروبه بين ضجيج الحياة وموسيقى اللغة، حتى صار أحد أبرز شعراء ومترجمي العراق المعاصرين. لم يكن طريقه معبّدًا بالتقليد، بل كان مشروعه الثقافي امتدادًا لوعي مبكر بأهمية الترجمة والتثاقف الإنساني. تخرج من كلية اللغات – فرع اللغة الإسبانية عام 1988، ليعود بعدها إلى مقاعد الدراسة في كلية التربية – قسم اللغة الإنكليزية، متخرجًا منها عام 2004، ثم نال الماجستير في اللغة الإسبانية عام 2023، حاصدًا بذلك ثمرة مسيرة طويلة من الاجتهاد الأكاديمي والعملي. لكن حسين نهابة لم يكن مجرد طالب للعلم، بل كان حاملًا لمشعل الكلمة في زمن الظلام، إذ راح يكتب الشعر ويترجم الكتب، ويفتح أبواب الثقافة عبر المؤسسات التي أنشأها وأدارها. فقد أسس "مؤسسة أبجد الثقافية"، وأطلق مجلة "الدراويش" الورقية باللغة الإسبانية من قلب مدريد، كما ترأس مجلس إدارة صحيفة "الأديب الثقافية"، ومجلة "كلكامش"، وشارك بفاعلية في نقابات واتحادات أدبية وصحفية، منها اتحاد الأدباء والكتّاب العراقيين، وجمعية المترجمين العراقيين، واتحاد الناشرين العرب. ترجَم حسين نهابة أكثر من ثلاثة وعشرين كتابًا من الإسبانية إلى العربية، تتوزع بين الرواية، والمسرح، والشعر، والسير، معرّفًا القارئ العربي على أسماء كبرى في الأدب اللاتيني مثل اليخاندرا بيثارنيك، أوكتافيو باث، انريكيه فيلا-ماتاس، وإسحق عظيموف. كما أطلق مشروعًا معاكسًا لا يقل أهمية، حيث نقل الشعر والرواية العربية إلى اللغة الإسبانية، فكان جسرًا متينًا بين الضفتين، حتى استحق أن يوصف بأنه "قنطرة ثقافية" تربط الشرق بالغرب. ولا تكتمل صورة نهابة دون الإشارة إلى صوته الشعري المتفرد، إذ أصدر تسعة دواوين شعرية، من أبرزها: تجليات عطشى، طقوس ما بعد الأربعين، فجر التعاويذ، ومائة شيبة وشيبة. وقد تُرجمت قصائده إلى الفرنسية والإنكليزية والإسبانية، ما جعله شاعرًا عالميًا بالمعنى الحقيقي، صوتًا يتردد في فضاءات متعددة، من الضاد إلى القشتالية، ومن بغداد إلى مدريد. رأى فيه النقّاد صوتًا شعريًا حداثيًا متجددًا، يجمع بين تراث الشرق وقلق المعنى الغربي، يكتب بلغة مترعة بالإيحاء والانزياح، تتخذ من الأسطورة، والرمز، والتجربة الشخصية مفاتيحًا للدخول إلى العالم. وقال عنه أحدهم: إنه لا يترجم فقط لغة الآخر، بل يترجم روحه، ويحملها بيد الشعر إلى الضفة الأخرى من النهر. إن تجربة حسين نهابة ليست سيرة ذاتية فحسب، بل هي شهادة على زمن عربي عاش تحديات الهوية والانفتاح، وحاول أن يعيد تعريف الثقافة بوصفها لقاءً لا صدامًا. شاعر، مترجم، ناشر، ومثقف من الطراز الأول، صنع من الحرف أجنحة، ومن الترجمة رسالة، ومن الشعر وطنًا يسكن فيه من لا وطن له. في زمن التباسات المعنى، يظل حسين نهابة شاعرًا يكتب ليضيء، ويترجم ليبني، ويؤمن بأن الكلمة، إن كُتبت بصدق، تستطيع أن تعبر البحار كلها دون أن تغرق. |
| المشـاهدات 50 تاريخ الإضافـة 05/10/2025 رقم المحتوى 67050 |
 أخبار مشـابهة
أخبار مشـابهة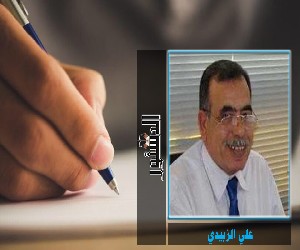 |
 في الصميم
وحيدة خليل والدعاية الانتخابية!! في الصميم
وحيدة خليل والدعاية الانتخابية!! |
 |
 تعن مهرجان الاسكندرية السينمائي
كتاب لميرفت عمر عن اعم 100 فيلم سياسي تعن مهرجان الاسكندرية السينمائي
كتاب لميرفت عمر عن اعم 100 فيلم سياسي |
 |
 رضا الباهي في «مهرجان الإسكندرية» : السينما المصرية
شكلت وجداني وتجربتي رضا الباهي في «مهرجان الإسكندرية» : السينما المصرية
شكلت وجداني وتجربتي |
 |
 في مهرجان الاسكندرية السينمائي ندوة تكريمية وكتاب عن ليلى علوي في مهرجان الاسكندرية السينمائي ندوة تكريمية وكتاب عن ليلى علوي |
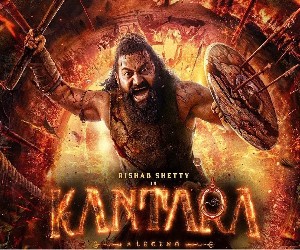 |
 فيلم الكانادا الهندي كانتارا
يتصدر البوكس أوفيس الهندي في أكتوبر 2025 فيلم الكانادا الهندي كانتارا
يتصدر البوكس أوفيس الهندي في أكتوبر 2025 |
 توقيـت بغداد
توقيـت بغداد 


