 زمن المعادلات المعكوسة
زمن المعادلات المعكوسة
 |
| زمن المعادلات المعكوسة |
  
|
 كتاب الدستور كتاب الدستور |
 أضيف بواسـطة addustor أضيف بواسـطة addustor |
 الكاتب رياض الفرطوسي الكاتب رياض الفرطوسي |
| النـص :
في عالمٍ لم يعد يعرف السكون، تتقاطع المصالح وتتصادم القوى في رقصةٍ دقيقة تحكمها الحسابات الباردة لا العواطف. في قلب هذا المشهد تقف الصين، بثقلها الاقتصادي وحذرها السياسي، تراقب اشتعال الساحات من أوكرانيا إلى الشرق الأوسط، وتحسب خطواتها كما لو كانت تحرّك قطع الشطرنج على لوحةٍ من لهب.
منذ عقود، أدركت بكين أن معركتها ليست عسكرية بقدر ما هي اقتصادية. فهي تمسك بيدها ورقةً حساسة: أكثر من ثلاثة تريليونات دولار في الخزانة الأمريكية، واستثمارات عميقة في السوق الأمريكية المفتوحة أمام بضائعها. ومع ذلك، لم تتخلَّ عن تحالفها السياسي مع موسكو. إنها تسير على حبلٍ مشدود: رجل في واشنطن وأخرى في الكرملين.
لكن هذا التوازن الدقيق يخفي خلفه خشيةً عميقة. فالصين تعلم أن ما يحدث في أوكرانيا اليوم يمكن أن يتكرر على أراضيها غداً، عبر الأقليات أو الحركات الانفصالية. الغرب جرّب اللعب على وتر الأقليات من قبل، في "ميدان تيانانمن" عام 1989، ثم في شينجيانغ والتبت، وفشل. لكنه لم يتوقف. لقد بدّل فقط أدواته وأساليبه، من التحريض الإعلامي إلى توظيف الجماعات المقاتلة في حروبٍ بالوكالة تُعاد تدويرها كلما احتاج المسرح الدولي إلى دمٍ جديد.
وهكذا، حين نرى فصائل تقاتل في سوريا وتُستدعى من جديد إلى مشاهد أخرى، ندرك أن ظاهرة “البنادق للإيجار” لم تنتهِ. فكما عاد “العرب الأفغان” ليقودوا موجات العنف في التسعينات، فإن بعض المقاتلين الأويغور الذين خاضوا معارك في سوريا قد يعودون يوماً إلى الصين محمّلين بأفكارٍ وتجاربٍ قابلة للاشتعال في أي لحظة.
أما روسيا، فقصتها أعمق من أن تُختصر في حرب حدود. إنها معركة هوية ونفوذ ضد الغرب الذي يريد تقليم أظافرها منذ انهيار الاتحاد السوفييتي. وحين اشتعلت جبهات الشرق الأوسط من جديد، وجدت موسكو فيها متنفساً استراتيجياً. فكلما ازدادت الضغوط على واشنطن وتل أبيب، ارتفعت أسهم روسيا والصين في سوق الصراع الدولي. ولذلك لم يكن غريباً أن يتبدل الموقف من “حزب الله” بين عام 2006 واليوم، من الإدانة إلى المساندة الضمنية. لأن المزاج العالمي تبدّل، والمعادلات القديمة انقلبت على رؤوس أصحابها.
اليوم، القاعدة الجديدة بسيطة: عدوّ عدوي صديقي. فحين يسقط صاروخ يمني على طائرة أمريكية متقدمة، ويعجز الخبراء عن تفسير كيف اخترق كل طبقات الحماية، تُطرح الأسئلة حول المصدر والتقنية. والإجابة، غالباً، تحمل بصمة روسية أو دعماً تقنياً من الشرق. فالدعم لم يعد يُقاس بعدد الجيوش، بل بحجم المعلومة ودقّة التكنولوجيا.
ولعلّ السلاح الأخطر في هذا الزمن لم يعد الصاروخ، بل المعلومة. فكنز الأسرار الذي استولت عليه المقاومة الفلسطينية في غلاف غزة – من سيرفرات ووثائق استخباراتية – لم يكن غنيمة ميدانية فحسب، بل زلزالًا استراتيجياً أربك أجهزة كبرى. تتفاوض عليه اليوم قوى عالمية: الـCIA، الموساد، والمخابرات الإقليمية. إنها حرب بيانات بامتياز، حيث صارت المعلومة أغلى من الأرض، وأخطر من السلاح.
الصين تدرك هذه المعادلة. فهي تعلم أن سقوط روسيا يعني اقتراب السهم الأمريكي منها. لذلك تدعمها سياسياً وتستفيد منها اقتصاديًا، في علاقةٍ تحكمها الضرورة لا الثقة. فكلما غاصت واشنطن في المستنقعات، من كييف إلى غزة، زادت قدرة بكين على التمدد بهدوء في الأسواق والممرات والموانئ، كما يفعل الماء حين يتسلل في الشقوق بلا ضجيج.
ورغم امتلاك روسيا لترسانة نووية مرعبة، فإنها لم تُستدرج بعد لاستخدامها. فالتلويح بالسلاح النووي التكتيكي كان أقصى درجات التهديد، لأن الجميع يدرك أن غبار النووي لا يعترف بالحدود، كما لم تعترف سحب تشيرنوبل ولا مياه فوكوشيما بأي جغرافيا.
وفي خضمّ هذه الفوضى المنظمة، تواصل العواصم الغربية توقيع “الشيكات البيضاء” لإسرائيل، لكنها في داخلها تعرف أن الزمن تغيّر. فالعالم لم يعد يُدار من مكتبٍ في واشنطن أو من قاعةٍ في بروكسل. هناك قوى جديدة تكتب فصلاً آخر من تاريخ النفوذ: فصلاً بلا جيوشٍ معلنة، ولا تحالفاتٍ مستقرة، بل زمن المعادلات المعكوسة، حيث يُقاس النصر بالثبات، لا بالضربات، وحيث الحليف قد يكون في الظلّ، لا في الضوء.
وهكذا، في عصرٍ تتشابك فيه الجبهات وتتعانق الملفات، لم تعد الحرب تُخاض بالبندقية وحدها، بل بالعقل والمعلومة والاقتصاد. العالم يعيد رسم خرائطه، لا على الورق، بل في الظلال. |
| المشـاهدات 662 تاريخ الإضافـة 13/10/2025 رقم المحتوى 67322 |
 أخبار مشـابهة
أخبار مشـابهة |
 الإنسان بين الحرية والعبودية: سؤالٌ قديمٌ في زمنٍ جديد الإنسان بين الحرية والعبودية: سؤالٌ قديمٌ في زمنٍ جديد
|
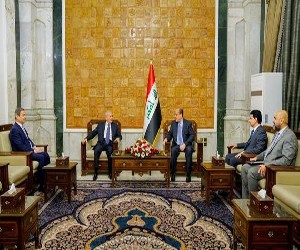 |
 بحث مع المالكي المسارات الجارية التي تفضي لحسم الاستحقاقات الدستورية وفق المُدد الزمنية المقررة لها
رئيس الجمهورية يبحث مع السفير الفرنسي مستجدات الوضع الإقليمي والدولي بحث مع المالكي المسارات الجارية التي تفضي لحسم الاستحقاقات الدستورية وفق المُدد الزمنية المقررة لها
رئيس الجمهورية يبحث مع السفير الفرنسي مستجدات الوضع الإقليمي والدولي |
 |
 زمنُ الأقنعة… حين صارتِ السرقةُ فضيلةً زمنُ الأقنعة… حين صارتِ السرقةُ فضيلةً |
 |
 وهّم الشعر في زمن النثر أزمة الذائقة الشعرية في العراق وهّم الشعر في زمن النثر أزمة الذائقة الشعرية في العراق |
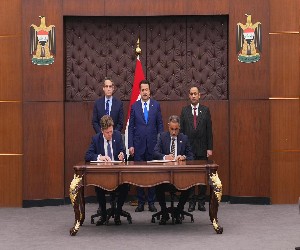 |
 السوداني: الحكومة اعدت جدولاً زمنياً محدداً لتحقيق أهدافها في مجال مشاريع الطاقة
العراق والولايات المتحدة يبحثان التعاون المشترك في مجالات النفط والغاز والطاقة
السوداني: الحكومة اعدت جدولاً زمنياً محدداً لتحقيق أهدافها في مجال مشاريع الطاقة
العراق والولايات المتحدة يبحثان التعاون المشترك في مجالات النفط والغاز والطاقة |
 توقيـت بغداد
توقيـت بغداد 


